ربيع اليمن: تجاهل الظروف الموضوعية لأزمة الدولة اليمنية
- عبدالملك العجري الثلاثاء , 15 فـبـرايـر , 2022 الساعة 6:33:56 PM
- 0 تعليقات

عبدالملك العجري / لا ميديا -
كما سبق يختزل رعاة «المبادرة الخليجية» مقاربة بناء الدولة في عدد من المفاهيم التي كانت توجه سياستهم، مفهوم الاستقرار، ومفهوم النخبة، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية في مؤسسات الدولة القانونية والدستورية، ولأن المجتمع الدولي كان على عجلة من أمره كان يعلي من دور الفاعلين في الإصلاح والتغيير على حساب البنى والإرادة وعلى حساب الظروف الموضوعية لأزمة الدولة اليمنية.
احتلت قضية بناء الدولة مساحة واسعة من الحوار الوطني إلا أنه استغرق في تلبية مطالب النخب السياسية والطموحات الليبرالية لبرجوازية المدن على حساب معالجة القضايا التي يشتد عليها الطلب الاجتماعي وحاجات المواطن الأساسية، والقضايا التي يحتاجها بلد على مشارف الانهيار والتفكك، فكان المؤتمر بمثابة سلة تسوق جمعت فيه كل قضايا ومطالب القوى السياسية والمدنية المتعارضة، ولم تتعامل بجدية مع المخاطر وعوامل التشظي والانهيار المتعددة، والاحتياجات الضرورية لاستشراف تطورها السلبي على مستقبل البلد والعملية الانتقالية، وانتهى مؤتمر الحوار دون أن يتمكن من تقديم إجابات لأهم القضايا التي تثقل كاهل البلد. وتمت إحالة بعض القضايا المستعصية للجان خاصة ترك لها اتخاذ القرار في المسألة الجوهرية، كانت بمثابة استكمال للفشل وإفراغ مؤتمر الحوار من مضمونه.
وعلى رأي الخبير الفرنسي فرنسوا فريز ونروش، وأستاذ القانون ووزير الخارجية الموريتاني السابق محمد الحسن لبات، فقد عبر ذلك الطرح عن تقليل لأهمية ماضي اليمن المثقل.
اتسمت عملية الحوار بضعف بين المنطق الاستراتيجي وإهمال تحديد الأهداف وهرمية المهام وترتيب الفقرات ووضعها على جدول واحد دون مراعاة لحدة الأزمة الشاملة. وتبنى «ما يقارب 1800 مقترح ذات طابع دستوري وقانوني أغلبها تتناول مبادئ ديمقراطية أساسية توجد في معظم دساتير العالم» تشكل في مجملها دولة مركبة من خليط غير منسجم من التوجهات الإسلامية واليسارية والليبرالية، وبشرت مخرجات الحوار بدولة رفاه فردوسية وإن كانت تمثل طموحات وأحلاماً مشروعة يتمنى أي حاكم أن يحققها لشعبه، لكن في بلد ودولة مثل اليمن توشك على الانهيار فإنها تبدو طموحات ليبرالية فائضة عن الحاجة، ولم يقل لنا مؤتمر الحوار ولا «المبادرة الخليجية» كيف ستوفر الموارد اللازمة والبنى التحتية لإقامة هذه الدولة الاتحادية ودولة الرفاه الاجتماعي الملتزمة بتقديم أعلى درجات الرعاية، ولم تلفت انتباههم القضايا الأشد طلباً للمجتمع والأزمة التي تعصف بشمال الشمال والجنوب التي كانت على هامش اهتماماتهم وهونت تقديراتهم من شأنها وتأثيرها على مسار الأزمة والعملية الانتقالية، حتى النقاط العشرون والنقاط الإحدى عشرة المتعلقة بقضيتي الجنوب وصعدة بقيت التزاماً على الورق لم ينفذ منها بند واحد.
لذا تساءل الكثير من اليمنيين عما إذا كان مؤتمر الحوار، الذي اكتنفه خليط أنواع وقدر من الغموض، مجرد مسرح للعبة دمى غايتها إخفاء توجهات أجنبية، والتقييم العام لمؤتمر الحوار الوطني هو أنه فشل، فقد كانت المهام المنوطة به أوسع وأكثر طموحاً من أن يتحملها مؤتمر للحوار، وبتركيبته تلك لم يكن مؤهلاً لمعالجة تعقيدات أزمة الدولة اليمنية.
تعقيدات أزمة الدولة اليمنية
تعزو كثير الدراسات أزمة الدولة إلى سياسات النخبة السياسية الحاكمة وغياب حكم القانون والحريات والمواطنة المتساوية وتفشي الفساد والرشوة والمحسوبية، وغيرها من المؤاخذات كلها لا نقاش فيها، لكنها ظواهر لا تكاد تخلو منها دولة، وإن بنسب متفاوتة، لاسيما في مراحلها التأسيسية، ولم يمنعها ذلك من بناء دول قوية ومؤسسات فاعلة تمكنت في النهاية من فرض الحوكمة وتصحيح كثير من مظاهر الخلل والحد من الفساد وإرساء سيادة القانون.
عادة ما يتم تضخيم مسؤولية القبيلة وتحميلها مسؤولية فشل الدولة، وإعاقة التقدم السياسي والاجتماعي، لكن في المقابل أليس العكس هو الأصح وأن ضعف الدولة هو السبب في قوة القبيلة؟ فعندما تكون هناك دولة قادرة على القيام بوظائفها يتراجع دور القبيلة وتتحول لمؤسسة اجتماعية، وأن الأزمات المزمنة للدولة ولدت وعياً عاماً لتوزيع السلطة بين الدولة والقبيلة تجعل الأخيرة أكثر ضماناً في وضع الأزمات وانعدام الاستقرار، تؤمّن الحماية وتلبّي الحاجات وتسوّي النزاعات بين أفرادها أو مع القبائل الأخرى وتعوِّض عن غياب الإمكانات والمقدرات لدى الدولة.
ثم لماذا تضطر النخب السياسية «بما في ذلك النخب المدنية التي اعتمدت -حسب الدكتور فؤاد الصلاحي- خطاباً سياسياً يبشر بالمواطنة ودولة القانون والتنمية لم تسع للارتباط العصبوي ونسج مفاصل السلطة حول عصبيتها، بل كان النضال الرومانسي هو ملمحها الأساسي» للاستناد للقبيلة رغم إدراكها أنها بذلك تضعف الدولة؟ لماذا النخب السياسية تتوسل الأدوات التقليدية لإدارة البلد؟ هل الأمر مجرد رغبة أم أنهم وجدوا أنفسهم أمام قواعد لعبة هي المتاح الممكن فدخلوها وزادوها قوة والدولة ضعفاً، وهل لو كان لديهم فائض من الوسائط المدنية كانوا اضطروا للوسائط التقليدية؟
النظام الاشتراكي في الجنوب تمكن من إزاحة القبيلة من الحكم، ولكنه فشل في بناء دولة قوية قادرة على القيام بوظائفها في الحماية والرعاية بكفاءة، وتحقيق تنمية شاملة ولم يمنع دورات العنف المتجددة التي أوصلت الدولة لمرحلة الإفلاس قبل الوحدة.
صحيح اليمن مجتمع تقليدي دخل مسار التحديث متأخراً إذا ما قورن بدول مثل مصر وبلاد الشام التي عرفت التحديث بعد حملة نابليون قبل مائتي عام، لكن هناك مجتمعات كانت أكثر تخلفاً من اليمن ودخلت مسار التحديث متأخرة ونجحت في تكوين دول قوية كحال دول الجوار اليمني بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم ولم تستطع الوقوف بوجه التحديث في بلدان كانت تتميز بطابعها التقليدي والقبلي.
باعتقادي إن الأمر لا يتعلق بتوفر الإرادة، وعندما ننظر لأزمة الدولة أو السلطة المركزية في اليمن في سياقها التاريخي نجد أنها كانت محكومة بمزيج من العوامل والعناصر والظروف الموضوعية تقلل من خياراتنا البشرية حيث يبدو الوضع أكثر صعوبة في السيطرة عليه، وأتفق مع ما قاله مؤلف كتاب «انتقام الجغرافيا» أنه كلما ازداد انشغالنا بالأحداث الجارية أو اليومية ازدادت أهمية الأفراد وخياراتهم، لكن كلما ازداد تدبرنا لما وقع في القرون الغابرة تزداد قناعتنا أن ما يحكم الاجتماع البشري والسياسي لا يتألف حصراً من عناصر حتمية أو فردانية أو عشوائية (الصدفة)، بل مزيج من الثلاثة.. على سبيل الماثل يشير إلى أثر الجغرافيا اليمنية في جعل اليمن دائماً مكاناً يصعب حكمه على الإطلاق «كانت اليمن تمثل ما أطلق عليه بعض العلماء المجتمع المجزأ تعصب بها الجبال الصحارى تجعله يتأرجح بين المركزية والفوضى، ويتجسد المجتمع في نظام يستنزف الحياة، وبسبب الهشاشة المتأصلة فيه فشل في إقامة مؤسسات دائمة، وتتسم القبائل بقوتها والحكومة المركزية بضعفها»، ويستنتج المؤلف من ذلك أن الصراع من أجل بناء أنظمة ليبرالية في مثل هذه الأماكن لا يمكن فصله عن هذه الحقائق، (انظر ص16 ص18 انتقام الجغرافيا). بناء الدولة في اليمن هو أشبه بحرب شاملة ضد الجميع، الحرب ضد الجغرافيا الطبيعية والموارد والاجتماع والقبيلة والنخب والجوار كلها تتضافر في مواجهة الدولة، ومع ذلك يبدو لي أن جذر أزمة الدولة يتمثل في شحة الموارد.
الدولة وأزمة الموارد
يقول الباحث تشارلز سميتر إن «مشاكل اليمن الاقتصادية حقيقية، لكنها ليست ناجمة عن نقص مطلق لا يمكن ترميمه في الموارد، بل هي حصيلة السياسات اليمنية التي تشكل العقبة الكأداء الرئيسة أمام التغلب على الصعوبات الاقتصادية الراهنة».
لكن، لا أميل إلى أنها مجرد سياسات وخيارات إرادوية فحسب، صحيح لدى اليمن موارد كافية للإقلاع الاقتصادي إذا ما توفرت لليمن فترة استقرار طويل الأمد دون أزمات أو حروب تساعده على مراكمة وتطوير موارده إلى الحد الذي يسمح باستيعاب وامتصاص أي أزمات أو أحداث مفاجئة دون أن تهز بنيانه أو تعيده لنقطة الصفر، أو في حال توفر وضع مثالي داخلي وخارجي وقيادة رشيدة شديدة الالتزام بالإصلاح، وتحلى الفاعلون المحليون والخارجيون بأعلى درجات المسؤولية لحين يقف اليمن على قدميه ويستطيع تشكيل مؤسسات حكم تتمتع بالقوة الذاتية، وتوافر مثل هذه الظروف الداخلية والخارجية أو معظمها هي من الصدف التاريخية القليلة.
اليمن لا يمتلك فائضاً من الموارد والإمكانات تجعله قادراً على استيعاب الأزمات المفاجئة سواء الطبيعية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، واستعادة قدرة الاقتصاد على الإقلاع، وتاريخ اليمن هو سلسلة من الأزمات المتناسلة قديماً وحديثاً، لم يشهد فترة استقرار طويلة الأمد ولا يمتلك موارد ضخمة تساعده على امتصاصها، وتأثير شحة الموارد يتجلى في أن أزمة واحدة تكفي لإضعاف قدرات الدولة، وإذا تجاوزتها بصعوبة فإنها لا تصل إلى مرحلة التعافي إلا وأزمة أخرى قد ضربتها، وهكذا فإن توالي عدة أزمات يكفي للوصول بالدولة للإنهاك، ومن جهة أخرى يتجلى تأثير شحة الموارد على شدة التنافس بين أصحاب الطموحات المتنافسين فهي لا تكفي لإرضاء الكل، الفائز يجد نفسه مضطراً لاسترضاء أصحاب الطموحات والمنافسين (وهو تحد تواجهه الدولة لاسيما في مراحلها التأسيسية)، ويحدث في كثر من الأحيان أن يكون الاسترضاء بتفويض الزعامات المحلية بعض سلطات الدولة، وبالتالي استنزاف الموارد في الصراع وفي استرضاء واستقطاب الزعامات والشخصيات المؤثرة، لا يبقى لديه فائض لبناء الدولة للقيام بوظائفها تجاه الشعب وتلبية احتياجات شعب لا يوجد توزان بين عدد وتوزيع سكانه وموارده الاقتصادية.
الأمر الثالث: إن شحة الموارد تجعل التنافس بين النخب حاداً، إذ لا يوفر ما يجعل الجميع كاسباً أو تحقيق مبدأ «الكل يكسب»، إنما طرف يربح كل شيء وطرف يخسر كل شيء.
ورابعاً: تجعل أنظار النخب السياسية وأيديهم ممدودة للخارج، الأمر الذي يعني تمهيد الطريق للخارج للتسلل إلى الشأن اليمني والتأثير على القرار السيادي، أضف إلى ذلك أن اعتماد الدولة بدرجة كبيرة على المعونات والمنح والقروض يجعل الاقتصاد متقلباً حسب التغيرات الإقليمية والدولية، وعندما يكون على رأس النظام العالمي منظمة التجارة والبنك والصندوق الدوليين فلا يجب أن نتفاءل كثيراً، ويزيد الأمر سوءاً أن خبرات بناء الدولة في اليمن هي عملية غير تراكمية، إنما تقوم على الهدم الثأري كل مرحلة تمارس تصفية انتقامية، انتقاماً من سابقتها، على سبيل المثال الدولة المتوكلية كانت قد نجحت في فرض سلطة الدولة والتغلغل إلى المدن والقرى والأرياف وأزاحت أقوى الزعامات المحلية التي تنافس الدولة، صحيح أنه كان بالاعتماد على أدوات الدولة القهرية وكانت بحاجة لأن يتبعها أو يترافق معها التغلغل من خلال التنمية (لأسباب قد نتناولها في مناسبات أخرى)، لكنها كانت خطوة يجب استثمارها والبناء عليها.
أزمة الدولة والإصلاحات المفروضة
اليمن كمعظم الدول العربية، لم تولد الدولة الوطنية الحديثة ولادة طبيعية ولا تطورت تطوراً طبيعياً على يد القوى المحلية، فهي من المفاهيم الجديدة التي جلبها الاستعمار، وكان الزمن السياسي الفاصل بين المفاهيم والقيم المؤسسية للدول الوطنية الحديثة وبين القيم التقليدية للمجتمع اليمني من الاتساع بحيث لا يمكن حرق المراحل لتسريع وتيرة التحديث وفرضه دفعة واحدة كما هي رغبة البرجوازيات المدنية إلا ويحترق البلد.
تحديث الدولة وظيفياً وعضوياً لا يمكن فصلها عن تحديث المجتمع أو بالانفصال عن أولوياته وحاجاته الأساسية ومستوى تطوره، فالتحديث ليس مجرد فرمان سياسي، وكثيراً ما أوقع النخب السياسية في فخ الرغبوية والتقليد والمحاكاة، في حين أن المجتمع هو الذي يوفر مصادر الدعم الذاتية للطبقة الحاكمة وآليات إدارة الصراع اللازمة، ومهما كانت الطبقة السياسية مدنية فإنها تبقى مفصولة عن المجتمع وتعتمد على الإسناد الخارجي وبقاؤها يبقى دائماً مرهوناً باستمرار الداعم الخارجي.
لا يعني هذا بحال من الأحوال أن اليمن لا يحتاج لمساعدة وعون أصدقائه لاسيما دول الجوار، ولا أنه في غنى عن الاستفادة من تجارب الآخرين أو أن الغرب لا يملك تجارب رائدة، لكن التصور الذي ساد منذ التسعينيات أن الديمقراطية والتعددية والسياسية والوصايا العشر للبنك الدولي والخصخصة هي قيم عالمية يجب على دول العالم امتثالها، وتقدمها وصفة سحرية كاملة وجاهزة لأي دولة تريد التخلص من المتاعب وتجاوز كل التحديات وتحقيق التطور والتنمية الشاملة والدخول إلى فراديس العالم الحديث، وصفة قابلة للتطبيق في أي مجتمع وفي أي ظروف اجتماعية واقتصادية، يكفي أن تمتثل لهذه القيم لتقلع نحو العالم الحديث على بساط الريح. وحتى في حال غياب قوى إصلاحية محلية قادرة على تبني وفرض هذه الإصلاحات فإن الغرب والولايات المتحدة جاهزون للتدخل بمختلف الأشكال الخشنة والناعمة لدمقرطتنا وإعادة هيكلتنا سياسياً واجتماعياً وثقافياً ومؤسسياً، هيكلة الجيش والمؤسسات والقوانين والشعب والقيم، وكأن مسألة بناء الدولة سلعة قابلة للاستيراد وإعادة الإنتاج. إلا أن نتائج أكثر من ثلاثة عقود من التحديثات المفروضة لم تنتج سوى ديمقراطية شكلية لا تضمن تغييراً، والتحديث مجرد شكل خارجي لإرضاء مجتمع المانحين ودول المركز حتى صارت الديمقراطية العربية ماركة خاصة بين الديمقراطيات في العالم، وأثبتت كما يقول مؤلف كتاب «انتقام الجغرافيا» أن موروث الجغرافيا والتاريخ والثقافة يفرض حدوداً لما يمكن تحقيقه في مكان بعينه.. وأن المقدر للعالم أن تحكمه أنواع مختلفة من الأنظمة، وأن الطريقة الأسلم أن يترك للشعوب فرصة التطور بقدراتها وخصائصها الذاتية، وأن تصل إلى الديمقراطية بطريقتها الخاصة وفي وقتها المحدد، وأن يترك لها أن تتعلم من الغرب ما تحتاجه وما هي مستعدة له والانفتاح على تجارب بلدان شرق آسيا الناجحة ومؤسساتها الإقليمية التي توفر تنمية أكثر عدلاً، بدلاً من فرض القيم الغربية والوصايا العشر للبنك ومنظمة التجارة على الشعوب كقيم عالمية، وبعبارة أخرى نعم للتحديث ولا للتدخل.. إن أي مشروع إصلاحي جاد يجب أن يكون استجابة لمطالب المجتمع المحلي وليس استجابة لقلق الخارج (وإن كان عليه مراعاة المخاوف المشروعة للخارج) وأن يراعي أولوياته لا أولويات المجتمع الدولي ومجتمع المانحين، وأن يكون مسنوداً بدعم الأغلبية كرافعة تساعد على وضعه موضع التنفيذ، وأن تكون له القدرة على استيعاب أكثر ما يمكن من القوى الاجتماعية حتى يستشعر الناس الحاجة والمصلحة في أي عمل إصلاحي وتجديدي.
نجاح أوروبا الشرقية في الاستقرار السياسي والاقتصادي يعود لتقبل شعوبها وحكامها لمبدأ تداول الحكم والاحتضان الاقتصادي لأوروبا الغربية ضمن الاتحاد الأوروبي ما ساعد في ضخ رؤوس الأموال والاستثمارات واليد العاملة، إضافة لدور الحلف الأطلسي في توفير الحماية، الأمر الذي أتاح لها التركيز على التنمية بدلاً من الدفاع وتقليص الجيش في الحياة السياسية، كما أن قربها الجغرافي من أوروبا الغربية ساعد على الاندماج الثقافي من خلال تقديم نموذج ملهم، أنها غيرت بقوة المجتمع المدني والوعي الشعبي وبروز قيادات وأحزاب قادت الثورة وضمها من الانقسام بعكس الأجواء الهادرة لـ»الربيع العربي» التي لم يجمعها إلا العداء للنظام، إضافة إلى غياب القيادة الثورية الملهمة. كما أتاح المجال للعسكر والأحزاب القيادية القادرة على جمع المعارضين واختراقها من التنظيمات الإرهابية والجماعات والأحزاب الأكثر تنظيماً، وافتقارها للاقتصاد القادر على مساعدتها على الإقلاع وشلل المجتمع المدني وانقسامه وتبعيته محلياً للأحزاب وخارجياً للموالين، ومن المفارقات أن الدول المستقرة والغنية في المنطقة العربية، هي الملكيات الخليجية، ولعبت دوراً جوهرياً في التأثير على عمليات التحول الديمقراطي، وفي حين كانت أوروبا الغربية الديمقراطية تقدم الدعم الاقتصادي والنموذج الجاذب للدول الديمقراطية المستقرة فإن الحصول على الهبات والمنح الخليجية كان يعوق التحول الديمقراطي باعتبارها دولاً تعادي الديمقراطية.

.jpg)











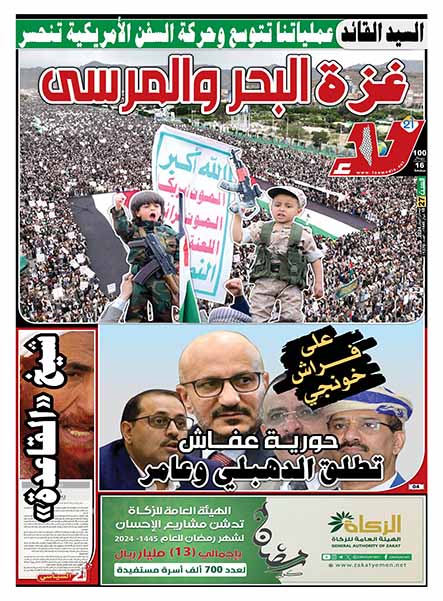




المصدر عبدالملك العجري
زيارة جميع مقالات: عبدالملك العجري