عن ماهية الثورة الشعبية وقضاياها
- تم النشر بواسطة علي نعمان المقطري

ليس كل تغيير سياسي في الحكم ثورة، ولا كل انقلاب سياسي أو عسكري ثورة. إنها ليست عملاً رومانسياً خيالياً أو مثالاً علوياً مفارقاً للواقع، بل هي وليدة الواقع الشرعي، كما أنها ليست نشاط أقلية لذاتها. وليس كل عنف ثورة. فما الثورة إذن؟ أليس فيها عنف وقوة؟ بلى فيها، لكن ذلك ليس جوهرها، ولا تُعرف به وحده.
المجتمع يولد الثورة.. والثورة تولد المجتمع
إن الثورة حركة اجتماعية تاريخية -ظاهرة اجتماعية- لا تنشأ في الفراغ، ولا تأتي مصادفةً دون مقدمات تفرضها حتماً كنتيجة السبب بالمسبب -العلة بالمعلول، فهي ظاهرة لازمت المجتمع الإنساني من بداية تكونه الأولي البسيط وتبايناته الاجتماعية واختلاف مصالحه، وفيها ـ كواحدة من تجليات الثورة الصحية - يصحح المجتمع انحرافاته وأخطاءه، ويعيد التوازن إلى الجماعة البشرية؛ لأن الاختلال في التوازنات يقضي على الاستقرار القائم، ويفتح المجال الى اختلال جديد في علاقات التعامل والعلاقات بين الجماعات المكونة للجماعة البشرية سواءً كانت أمه أو قبيلة أو شريحة أو قوماً أو شعباً...، فكل تغيير أو إخلال في التوازنات يقلب العلاقات حتماً. والمقصود هنا هي علاقات الخضوع والسيادة بين القوى والجماعات المكونة للمجتمع.
تسعى كل جماعة تكثيف ومضاعفة قوى وشروط نفوذها وسيادتها دوماً، بهدف تغيير وضعها داخل العلاقات القائمة، من وضع التابع والمسود والمحكوم إلى وضع الحاكم والمسيطر.
في المجتمع، تجري القوانين الطبيعية العامة الشاملة شاملة أو حاوية للصراع والتنافس والنزاع، اكتساب النفوذ والقوة والسيادة والبقاء، لكنها لا تجري كما يحدث في الطبيعة الحيوانية وملاكها، بل بطريقة معقدة ومختلفة، لكنها تحدث في النهاية، فالعقل والوعي شرط أساسي ناظم لما يحدث ويعتمل داخل المجتمع.
إنها - أي الثورة - ظاهرة ملازمة في المجتمع، سواءً جرت بطريقة عنيفة أو باردة وهادئة، لكنها في النهاية تحدث، وبالضرورة تحدث، ولابد أن تحدث. إنها بمثابة المتنفس للمجتمع من الضغوط والتناقضات المتكدسة المخزونة في أحشائه، بيد أنها حين لا تجد متنفسها؛ فإنها تنفجر وقد تمزق النسيج الاجتماعي. ولذلك فهي بمثابة البراكين والفيضانات والزلازل والأعاصير في الطبيعة، فهي أيضاً قفزات وخضات وتفجرات مفاجئة تخرج الطاقة المخزونة قبل أن تخنق الطبيعة نفسها، فهي -في الطبيعة- يضبطها قانون الضرورة الحتمي، أما في المجتمع فيضبطها قانون الوعي الاجتماعي والبصيرة والرشد العام، ففي الطبيعة يكون التخريب والتدمير هو الوجه الآخر لإطلاق الضرورات المحبوسة -بشكل مأسوي- أما في المجتمع فيتم ضبط حركته وتقييد الضرورات عبر ترشيده وترشيد انسيابها بطريقة تقلل من الأكلاف الإنسانية بتحويلها إلى مخطط واعٍ رشيد لتغيير وتحسين البيئة المجتمعية الإنسانية.
إن تاريخ الإنسانية الواعية هو تاريخ سيطرتها على تحركاتها وضروراتها الحتمية وأنسنتها -إكسابها الطابع الإنساني الواعي المثقف- فكلما زاد البعد الإنساني في إدارتها قلت الأكلاف والخسائر، وارتدى الصراع أشكالاً أقل وحشية وأقل شراسة وجشعاً ودناءة وخسة، وابتعد بنا عن مملكة الأسلاف القاسية إلى ممالك الحرية الموعودة. لن يدخل الإنسان جنة الله الموعودة إلا إذا ارتقى إلى مستوى جنة الإنسانية الدنيوية أولاً، فالجنة المطلقة لا يدخلها أبداً أنصاف بشر، أنصاف متوحشين.
وهذا يعني إعادة النظر دوماً بروحيتنا ومدى ترقينا على سلم الأخلاق والعقل والفكر، ومدى انعتاقنا عن ممالك التوحش التي تشد الإنسان عميقاً إلى الأرض، وتمنعه عن التحليق في فضاء السماء الرحبة الواسعة. وامتلاك الإنسان نظرات فكرية جديدة عقلانية لعقلنة المجتمع وعلاقاته بشكلٍ أكثر رقياً وتطوراً ووعياً، الأمر الذي يؤدي لتغيير العلاقات الإنسانية تدريجياً نحو جعل النزاعات من الماضي؛ فرُقي العقل والفكر لدى الجميع يجعل المصالح العامة واضحة وبديهيات لن تحتاج إلى الصراع لحفظها.
بيد أن الإنسان لا يمكنه الوصول إلى تلك الذرا من ذروات الفكر والوعي بسهولة دون ثورات عميقة ضرورية وحاسمة أولاً، كي تضع منهجاً يلزم الجميع أولاً باستخدام الإكراه القانوني والثقافي والمعنوي.
في الماضي كانوا يعتبرون الثورة شيئاً مكروهاً وممقوتاً ومعاقباً عليه في الكثير من الأنظمة، ومازال إلى الآن. ومع ذلك فإن الأنظمة الاستبدادية لا تستطيع الهروب من حقيقة ضرورة التغيير والثورات الباردة ومن أعلى (كما يسميها الكتاب الاجتماعيون)، كما أن الانقلاب العسكري يكون تغييراً من أعلى بشكل ثورة بيروقراطية من قبل الحكام أنفسهم أحياناً ضد أجنحة مقابلة، لأن الضرورات التغييرية تفرض نفسها بطريقة أو بأخرى، وليس التغيير بحد ذاته هو ما يزعج الاستبداد، إنما تغير العلاقات الاستبدادية هو الذي يقلقهم، لأن تغييرها لا يتم إلا في سياق ونتيجة الثورة والإكراه والعنف الشعبي، فالاستبداد لا يقبل أبداً بتغيير تلك العلاقات، لأن ذلك يعني بالضرورة تغيير موقعه من المجتمع والسلطة والثروة.
إن الثورة قانون تغيير العلاقات الاستبدادية السابقة بعلاقات جديدة أرفع وأكثر تطوراً، بل هي كظاهرة اجتماعية تنشأ في المجتمع كواحد من تجليات تناقضاته وصراعاته ونزاعاته وتوتراته الطبقية والسياسية التي تصل إلى الحد الأعلى الذي لا يعود ممكناً معالجتها بالأساليب القديمة العادية التسووية وأنصاف الحلول، بل تقتضي الحسم والقطع للعلاقات مع الواقع والتركيب القديم، فتدفع الثورات غضباً تراكمَ لقرون ومشكلات تنامت دون معالجة ومظالم لم تُنصف طوال عقود.
يلخص أحد القادة الثوريين لثورة روسيا البلشفية، بالقول إن الثورة تحدث عندما يعجز النظام القديم عن مواصلة الحكم بالطريقة القديمة، ويصل الناس في وعيهم إلى رفض العيش بالطريقة القديمة، وإلى الأزمة التي تشمل الحكام والمحكومين كأزمة وطنية تشمل جميع جوانب المجتمع، على المستوى الفوقي -أجهزة السلطة والإدارة والتحكم والتضليل والأيديولوجيا- والمستوى التحتي، أي أن الأزمة تستحكم وتصيب البنية الفوقية كما التحتية، وبالطبع هذا لا يكفي نشوء ثورة ظافرة وناجحة، لكن لابد أن يشمل النزاع السياسي الاقتصادي الطبقات الرئيسية في المجتمع -الطبقتين المسيطرتين على الإنتاج الاجتماعي- اللتين تشكلان مراكز القوة كطبقة ظالمة مُستغِلة وأخرى مظلومة مُستغَلة التي تشكل عددياً أغلبية الشعب والأمة، ويكون النزاع قد وصل بينهما إلى درجة القطع، وبدون بلوغ ذلك القطع، فإن الثورة قد تخبو وتتراجع بعد فترة من الاضطرابات والمحاولات، لأن الثورة لا تحدث إذا لم تشارك فيها الطبقات الرئيسية في المجتمع، وإذا لم يكن النظام الاقتصادي السابق قد استنفد ولم يعد صالحاً لتحقيق مصالح الطبقات من طرفيه، خاصة المنُتِجة المُستَغَلة المقهورة، وصار لها بديل اقتصادي أوسع وأرحب -يمكن الانتقال إليه- ويسمونها بعلاقات الإنتاج الاجتماعي الاقتصادية الجديدة التي تحقق المصلحة الاقتصادية للطبقات المظلومة، أما إذا كان هذا العامل غير متوفر بعد فإن الثورة تواجه معوقاً كبيراً في الواقع الاقتصادي الاجتماعي، ويصعب تحولها إلى ثورة اجتماعية اقتصادية سياسية ثقافية شاملة، وقد تصير -فقط- مجرد مشاغبات سياسية حول السلطة ومجرد مشاغبات قصور داخلية بين أجنحة النظام ذاته وفي إطار العلاقات الاجتماعية نفسها.
حول إسقاط النظام
حين يقال الثورة إسقاط لكامل النظام وللنظام -أي المنظومة- بكل أجنحته ومؤسساته وقواعده وعلاقاته الاقتصادية المجتمعية السائدة، أي علاقات الاستثمار السابقة وعلاقات التملك والملكية والسيطرة المالية والقانونية، أي أنها قطعٌ جذري مع علاقات التملك والملكية والاستثمار والحقوق القديمة التي كانت تمنح لطبقات وتحرم أخرى، ولابد أن تعيد الطبقة المحرومة صياغة القوانين والقواعد وفقاً لمصالحها هي في مواجهة الطبقة المهيمنة السابقة.
(النضوج) ضرورة
حين يُقال إن ثورة لم (تنضج) تناقضاتها وأسبابها وشروطها، ولم تستنفد بعد العلاقات القائمة، فالمقصود أن الطبقة/ات الثائرة وطليعتها لم تفهما بعد ضرورة القطع مع الماضي وضرورة التضحية والاستعداد للمواجهة وتحمل الأكلاف الإنسانية للخلاص، كما لم تفهما بعد المتطلبات الذاتية والموضوعية. كما أن نضوج الثورة يعني أن التشكيلة البديلة للاقتصاد وللعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة موجودة وناضجة، ويمكنها أن تحل محل العلاقات القديمة وتدفع بالمجتمع إلى التقدم لا إلى أزمة جديدة لا فكاك منها.
وذلك لا يعني التوقف عن الكفاح، وإنما معرفة حدوده في كل مرحلة. بمعنى أن يعرف الثوار إلى أين يمكنهم المضي وأين يجب التوقف والانعطاف ومتى تتوجب المرونة ومتى يتوجب الحسم والاندفاع.
(العدالة الاجتماعية).. هدف الثورة
جميع الثورات السابقة تحدثت عن هدف (تحقيق العدالة الاجتماعية) بين الطبقات وإزالة الاستغلال بين البشر. ومنذ الثورات القديمة والحديث لا يتوقف عن العدالة، ويحدث تغير اجتماعي نسبي، لكن (العدالة) تظل بعيدة عن التحقيق.
وهذا يعني أن مفهوم العدالة ليس مثالياً وتجريدياً، وإنما يعكس نظرة كل طبقة إلى العدالة التي تتمناها هي وتتطابق مع مصالحها هي. ومن هنا لم تتحقق أهداف العدالة ولو أبسطها.
قيل قديماً (لا يعرف معنى العدل إلا من يعاني الظلم). وهذا نصف الموضوع، فالشق الباقي منه هو: أن تكون له مصلحة حقيقية في تحقيقه.
المحتوى الطبقي (للعدالة الاجتماعية)
في الثورة الفرنسية، كانت طبقة البرجوازية المثقفة هي حاملة مشعل الثورة والعدالة الاجتماعية. وقد قيدت المفهوم والفكرة بمصالح العدالة التي تحرر البرجوازيين والتجار والأغنياء الرأسماليين من القيود الإقطاعية السابقة فقط، أي أنه مفهوم أقلَّوي بالنسبة للبرجوازية الصغيرة والكبيرة، فكلاهما تريان العدالة في ما يحقق لهما حريتهما، وبطبيعة الحال، فهي تتضمن الاستغلال للآخرين ولو بطريقة مموهة أو جديدة ومختلفة. إذ إنها لا تقضي على القيود المكبلة والظالمة للمجتمع ككل، بل الواقعة عليها، وبذلك فهي تبقي على الاستغلال والظلم في العلاقات الجديدة.
وفعلياً، عندما حاولت الطبقات الأفقر والكادحة والمحرومة الحصول على حقوقها التي وعدتها بها البرجوازية -إذ هي من ساندتها ضد الإقطاع والرأسمال الكبير- في الثورة الفرنسية الكبرى، فقد عادت وتنكرت لها وأذاقتها الويل والعنف والقمع. ونعرف الآن كيف قامت بتصفية ممثليها في البرلمان والجمعية العامة للجمهورية -أفضل رجال فرنسا وأبرزهم كـ(لويس دانتون) و(سان جوست) و(مارات) - فقد أعدمتهم بالمقصلة، وسرعان ما سقط الذين أعدموهم لاحقاً.. ولقد أدت تلك الأحداث إلى سقوط الثورة والجمهورية بأيدي (اليمين) الرأسمالي الذي بدوره أتى بـ(نابليون بونابرت) حاكماً إمبراطوراً مدى الحياة.
ومجدداً ساندت الطبقات الكادحة العمالية - البرجوازية لإسقاط ملكية حزيران 1848م (لويس فيليب)، فقد جاءت البرجوازية بلويس نابوليون رئيساً للجمهورية - مجدداً - غير أن البرجوازية حرمت العمال من حق الترشيح والانتخاب، وبدأت تقمع حراكاتهم الديمقراطية، وأغلقت المصانع لإجبارهم على مواجهة الجوع والخضوع، لينقلب بعدها (لويس نابوليون) عليها، ومعلناً نفسه إمبراطوراً -مدى الحياة- في العام 1852م، بعد أن حصل على التصويت المطلوب من الجمعية العامة التي كانت تضم الأغنياء وحدهم.
وفي العام 1870م تنازل عن باريس للألمان بعد خسارته الحرب ضدهم ووقوعه بكامل جيشه الإمبراطوري في أسر بسمارك المستشار الحديدي لألمانيا.
ومجدداً تساند الطبقات الكادحة العاملة - البرجوازية لاستعادة الجمهورية والقيام بالثورة مجدداً. ومرة أخرى يحاول العمال والعوام الحصول على العدلة ولو جزئياً، فلم يحصلوا على شيء غير العنف الذي كان جواباً على كل حركة مطلبية لهم.
بعد سقوط الإمبراطور أسيراً وجيشه في سيدان، احتُلت أقسام كبيرة من فرنسا بدون مقاومة، وتحركت البرجوازية المالية الفرنسية مسارعةً التفاوض مع المحتل الأجنبي على استعداها لتسليم العاصمة وسلاحها ودفع التزامات مالية مقدرة بـ6 مليارات مارك ذهبي، وتسليم أقاليم فرنسية حدودية لألمانيا، وقمع الطبقة العاملة التي دافعت عن العاصمة، واستلام مدافعها وتسليمها للألمان بالقوة!
كانت هذه التصرفات تكشف مدى بشاعة الرأسمالية الفرنسية التي كانت دائماً مستعدةً لخيانة الوطنية مقابل البقاء في عرش السلطة ولو بالتبعية للأجنبي المحتل. فيما (البروليتاريا) ظلت ترفض الصفقة الخيانية متمسكةً بمدافعها التي شرتها من أموالها الخاصة كتبرعات عامة قامت بها، وليست من الجيش الرسمي.
ما الذي جرى؟
لقد ذبحت نصف مليون عامل في باريس بالرشاشات وهم عزل. كانت تلك ما سميت (كومونة باريس) الشهيرة، حين أعلن العمال حكومتهم، وسيطروا على العاصمة في انتفاضة شعبية عارمة استهدفت تحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي ومن الظلم الرأسمالي المشترك.
سردنا طويلاً محطات من العلاقات التاريخية بين البرجوازية والبروليتارية العمالية، خاصةً في فرنسا، لأنها تشكل نموذجاً ناضجاً للعلاقات الطبقية المتبادلة بين الطبقتين الرئيسيتين في المجتمع الحديث، وهي تتكرر في جميع الثورات والبلدان الأخرى بصورة أو بأخرى، فالقانون واحد.
أردنا الوصول إلى استخلاص هام جداً هو: أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق أبداً في ظل الحكومات البرجوازية والبرجوازية الصغيرة والبيروقراطية أو الإقطاعية والاستبدادية. لماذا؟
لأن مصالح تلك الطبقات جميعاً تقوم على استغلال العمال والفلاحين والفقراء والكادحين، تستغلهم بكل الطرق، لأنها الطبقات التي لا تعمل ولا تنتج ولا تقدم أي عمل للمجتمع، وهي تعتمد في دخلها على الاختلاس والفساد ونهب المال العام والثروات الوطينة، أو التشارك مع المحتل الأجنبي أو التبعية والهيمنة والاستيلاء على (القيم الزائدة) للمنتجين دون دفع قيمها لأصحابها من الشعب العامل، ولن تحصل على دخلها وتبقي على نعيم حياتها إلا عبر الأساليب الفاسدة الملتوية والأرباح الفاحشة واللصوصية والجريمة والفساد. فكيف يمكنها أن تحقق العدالة الاجتماعية للطبقات العاملة والفقيرة والمحرومة؟!
الثورة.. ثورة الكادحين
إن مصير العدالة الاجتماعية مرهون بثورة الكادحين وحدها، مرهونة بسلطتها وحدها، وهي الوحيدة القادرة على تحقيق العدالة للجميع والمستفيدة منها فقط.
كان القانون الناظم لموقف البرجوازية الفرنسية -وكثير من البرجوازيات- إزاء العمال والفقراء، هو أنها تتقرب إلى العمال بالإغداق عليهم في الوعود عن العدالة كلما احتاجت لهم لدحر العسف الإقطاعي واستعادة سيطرتها على السلطة، بينما تتعامل معهم بعنف كلما شعرت أنها قوية ومتصالحة مع الإقطاع السياسي.
وفي هذا السياق، يمكن استقراء المقولة الإنسانية الفلسفية والعلمية العميقة للإمام علي (عليه السلام): ما اغتنى رجلٌ إلا بفقر عشرة. واليوم صار هذا الحال أشدّ شراسة مما كان عليه ذلك الزمن، فصار الغنى على حساب إفقار وتجويع المئات بل الآلاف ومئات الآلاف.

.jpg)









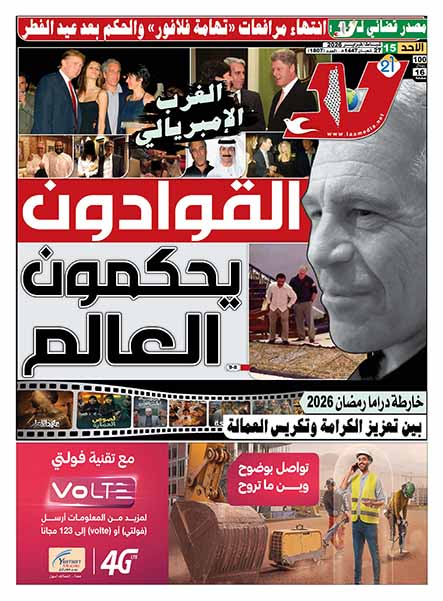
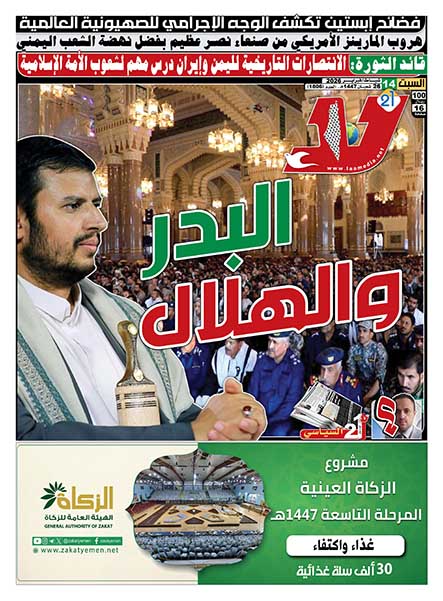





المصدر علي نعمان المقطري