المخرج والكاتب والممثل السوري عبداللطيف عبدالحميد في حوار خاص مع «لا»:الشعب اليمني موهوب وأرحّب بالتعاون معه سينمائياً
- تم النشر بواسطة حنان علي / لا ميديا

حاورته في دمشق: حنان علي / لا ميديا -
متلمساً حكايات الجبال الوعرة والسواقي، خاض عباب الطبيعة الشرسة، مصغياً لمكابدات المكافحين، صرخاتهم وأفراحهم الضئيلة، العاشق للصورة، ناسجها، بإحساسه أدار الكاميرا، وبروحه دوّن أحداثها. بذور التين أفكاره، ورؤيته مهادُها الخصيب. صاحب الرسالة الإنسانية. آسر الجماهير وحاصد الجوائز، المخرج عبداللطيف عبدالحميد، الكاتب والممثل، يؤجج ذاكرة الشغف والتفوق بين ربوع «لا»، في حوار لا يُنسى.
استقرأت مصيري مبكرا
دعني أستحضر طفل السبعة أعوام «الغزيّل» الملبي لدعوة «نجاح سلام» بأول فيلم حضره، فهل استقرأ مصير مخرجٍ يقف خلف الكاميرا، أو تخيل قلماً يخطّ مسيرة إبداع؟
بعد انتهاء العرض لم يدهشني الفيلم فحسب، بل كل الأشياء الحاضرة، من الصورة إلى الصوت إلى الأغنية. طوال عبوري للدرب الترابي الطويل المؤدي إلى البيت، ما لبثت أدندن: «ميل يا غزيل»، مستدعياً جميع الأصوات المرافقة. لاحقاً تشكلت لديّ مفاتيح الصوت أو ما يسمى المكساج. لم يخطر ببالي التمعن بما طرحتِه قبل الآن، فإن أردتِ إجابتي، فأجيبك: نعم!
صعوبة تجسيد الواقع سينمائياً
الطفل نفسه قطع الوديان والتلال في دربه الموحل إلى مدرسته، مختبراً قسوة مناخ الضيعة. إلى أي مدى ساهمت هذه المعاناة بطبع ذاكرتها فوق مخطوطات نصوص أفلامك؟
ما برح الواقع يقسو أكثر، ومن الصعب تجسيده سينمائياً؛ لكنك تجدين الإجابة في فيلمي «قمران وزيتونة»، وفيلم «العاشق». طريقٌ طويلٌ مكسوّ بالجليد، ويدان تعلقان دلواً طافحاً بالعجين، متورمتان من شدة البرد والوجع. مهما بلغت البراعة فإن الإحساس المرافق يستحيل تحقيقه بالسينما. حاولت قدر استطاعتي تجسيده أثناء عبور السواقي بوجه الرياح العاتية.
إحباط مبارك
فلنسترجع ذاكرة الشاب العازف للعود، والمؤلف الموسيقي، وأول إحباطاته المؤلمة المباركة التي غيرت مساره انعطافاً إلى عوالم السينما...!
في السبعينيات كانت كفة الموسيقى لديّ أكثر رجحاناً؛ لكن ذلك لا ينفي عشقي للإخراج والتمثيل والخوض في عوالم الصورة والمسرح. لطالما خلدت إلى آلة العود، وكثيراً ما عزفت للعائلة والأصدقاء. تقدمت بعد ذلك لاختبارات القبول في البعثات الموفدة إلى خارج سورية، مؤثراً اختيار الموسيقى كرغبة تسبق الإخراج. ورغم حصولي على درجة تامة، إلا أن المؤلف الموسيقي صلحي الوادي، المترئس للجنة الاختبار آنذاك، تعامل معي باستخفاف شديد، حتى أنه رفض الإصغاء لعزفي معتذراً: «يا بني، بعثاتنا كلها إلى الدول الاشتراكية، ولا نفع لعودك هذا». أصابتني عبارته بجرح عميق أعادني مثقلاً بالإحباط إلى اللاذقية. بعد ذلك حرصت على التقدم لبعثة الإخراج، فقُبلت وسافرت إلى موسكو لأخضع، مع أربعين مبتعثاً من دول العالم، لحصارٍ نفسي هائل يؤول لقبول عشرة للدراسة بالمعهد العالي للسينما، بعض الطلاب لم يتحملوا الضغط النفسي فانسحبوا، أما عني فقد شاء الحظّ أن ألتقي بشاب سوري أنهى لتوه دراسة الموسيقى، أصغى لعزفي وطلب مني بعض مؤلفاتي الموسيقية، قدمني بعدها إلى مدير معهد الموسيقى هناك، لعلّي -وفق تعبيره- أجد فرعاً بديلاً إذا أخفقت في امتحانات القبول السينمائي. قابلت مدير الكونسرفتوار، الذي اختبر قدرتي على مجاراة نغمات أصابعه على البيانو، وانتهى بالترحيب قائلاً: «المعهد معهدك يا بني»، داعياً إياي للالتحاق بالمعهد؛ لكنني آثرت الإخراج على الموسيقى. الطريف بالأمر أنه بعد النجاح الكبير لرسائل شفهية عام 1992، وعلى هامش إحدى الندوات، التقيت مصادفة بالأستاذ صلحي الوادي، الذي تأهب مرحباً مهنئاً، فلم أتوانَ عن البوح بمكنوناتي تجاهه، سارداً أحداث ذلك اليوم البعيد، مستهلاً بالقول: «في سنة 1975 تقدم شاب لامتحان القبول في المعهد الموسيقي جوار جامع الثريا، في حيّ الميدان موقف أبو حبل. شخصياً يا أستاذ أحمل شعوراً مزدوجاً تجاهك، فلا أعلم هل أحقد عليك أم أشكرك!».
رهبة أولى الجوائز
ساحر الجماهير وحاصد الجوائز المحلية والعربية والعالمية بدءاً من أيام دراستك في موسكو وانتهاء بتكريم فيلم «الطريق» الذي نال مؤخراً الجائزتين: الجائزة الذهبية الكبرى بتصويت الجمهور، وجائزة لجنة التحكيم الكبرى في «مهرجان سينيالما» في فرنسا. إلى أي مدى ترهقك المحاكمة الذاتية؟
(بمرح) المحاكمة الذاتية؟! أنى لكِ معرفة ذلك؟! بالفعل، الذعر هو ما أصابني منذ حصاد الجوائز الذهبية الثلاث الأولى: السيف الذهبي بمهرجان دمشق، والزيتونة الذهبية بفرنسا، وذهبية أفضل ممثل للكبير أسعد فضة. وفي إجابة عن المشاعر المرافقة لهذا التكريم في لقاء إذاعي أجراه معي المذيع طالب يعقوب، أجبت: «أشعر بسيوف ثلاثة تقطع عنقي!»، إن كانت البداية على هذا النحو، فأي رهبة تكفن الخطوة التالية؟!
رأي زوجتي كان مقياس أعمالي
الأب العسكري ابن المدينة، والأم الريفية، الزوجة الراحلة لاريسا عبدالحميد رفيقة الدرب، الابنة التشكيلية المبدعة... ما كانت أدوار الداعمين من العائلة والأصدقاء الأبرز في حياة عبداللطيف عبدالحميد؟
كلّ منهم كان بارزاً في مجاله. دعيني أذكر بالأقرب لقلبي، المرحومة زوجتي، التي شاركتني الأفكار منذ بزوغها في رأسي. كنت أخضع ما أنوي القيام به لردة فعلها أولاً، معولاً على تكوينها النفسي ووجهات نظرها المتمايزة كامرأة أوروبية. لم تبخل بدورها بالدعم أو بالرأي أو بالحب. كانت من شدة حرصها، تشعرني كأن الفيلم لها شخصياً.
صديقي الناقد الشرس
هل فاقتك عشقاً؟
رغم صعوبة سبر الجوهر البشري، لكن تفاصيل حياتنا كانت تشي بما في قلبها على الدوام. قبل وفاتها بسنتين، أصابني شلل العصب السابع، فما إن رأت وجهي سارعت لإسعافي إلى المستشفى بكل ما تحمله من لهفة وحنان واهتمام، رغم حالتها الصحية السيئة. من الأصدقاء أذكر حسن سامي يوسف، الصريح الواضح كما الدمعة، لم يجاملني يوماً وكان الناقد الشرس لأعمالي.
إحساسي هو من يحرك الكاميرا
هل من تقنيات أو أساليب سينمائية مغاير تميز عبداللطيف عبدالحميد؟
أظن أن غيري يمكنه الإجابة على السؤال أفضل مني؛ لكني سأجيبك بأنني شخص يميل إلى البساطة المشكلة لعمق معين، لا أحب الاستعراض، بل أحرك الكاميرا تبعاً لإحساسي.
«الطريق» أنهكني
لا تتقصد اختيار النجوم، بل الممثلون من يطرقون باب خيالك أثناء كتابة النص. كم مرة عارضت تصورك اللاإرادي واخترت ما يخالفه؟
أكثر فيلم أنهكني من هذه الناحية هو فيلمي الأخير: «طريق». حين شرعت صورة وصوت موفق الأحمد يطرق مسامعي منذ اللحظة الأولى، استسلمت للحالة، ونادراً ما أفعل، ثمّ تابعت الكتابة. لعلّ تبادره للذهن لم يكن عبثاً ولا صدفة، حتى أنني تنبأت له بجائزة حين عرضت عليه الدور، وهذا ما حدث بالفعل. فموفق الأحمد فنان جديّ للغاية.
تدبر بحكمة ودراية
كيف تمكن عبداللطيف عبدالحميد من تحقيق التوازن المثالي بين الإبداع الفني وظروف صناعة السينما الصعبة في أعماله السينمائية؟
لن أطيل الحديث بهذا الشأن، فأنا أشبه نفسي برب الأسرة محدود الدخل، تكمن وظيفتي في التدبر بشؤونها بحكمة ودراية.
مشهد أثار صراخي
هل يمكنك مشاركة نادرة مضحكة وراء الكواليس حدثت أثناء تصوير أحد أفلامك؟
في مشهد حلاقة شعر الفتاة في فيلم «قمران وزيتونة»، دعوتُ والدتها لحضور المشهد، مؤازرة لابنتها؛ لكن ما إن شرعت نورمان أسعد بالحلاقة، علا نحيب الأم مثيرة جنوني، فصرخت بوجهها لتغادر إلى حيث كانت! فما كان من الابنة إلا قلب الأدوار وتهدئة أمها.
مظهر سوريالي
إذا ألقيتَ فكرتك في الذهن ونسيتها، فالحكمة تشير بعدم جدواها. كيف تتولد أفكارك؟ هلا ذكرت لنا الشعلة الأولى لبعض أفلامك؟
في مظهر سوريالي جاف لا يدل على شيء، أذكر أنني ناديت مدير الإنتاج لمناولته بطيخة من الطابق الثالث لفندق نقيم فيه باللاذقية. ابتعد الرجل مذعوراً، تاركاً البطيخة تتفجر متناثرة الأجزاء، فبزغت لديّ فكرة «صعود المطر».
فكرة أخرى أطلقها ولد قادم من حكايةٍ من الصعب تجسديها بالسينما، لهول قسوتها. كان طفلاً تعاقبه أمه للتخلص من وسواسه القهري باقتلاع شعرات رأسه. استخدمتُ في قمران وزيتونة وسواس مصّ الإصبع. أما الشعلة فبدأت إبان الأزمة الاقتصادية عام 1984؛ كنت مقيماً في مخيم اليرموك، وكان التبغ مفقوداً، وكانت الشرطة العسكرية تقوم بين حين وآخر بتوزيعه على متن شاحنة كبيرة. انطلقت السيارة قبل حصولي على حصتي، فرحتُ أركض خلفها، وإذا بي أرى مصطفى شاباً يهرول جواري!
الرقابة رفضت النص
لماذا لم تخلق من المشهد فيلماً؟
أردت ذلك؛ لكن الرقابة رفضت النص؛ إنه مصطفى ذاته، من ركضت جواره، طفلين يطاردان ابن آوى السارق لبيضة دجاجتي المدللة، ثم انعطف ملبياً نداء أمه، مفارقاً إياي لـ25 سنة التقينا بعدها على الحال ذاته راكضيْن لاهثين خلف سيارة «الزيل».
دعوته إلى البيت وتحادثنا مستحضريْن ذكريات الطفولة، لأكتب بعد مغادرته خاطرة، توالدت أفكاراً على مدى شهر كامل لم تسعها 800 صفحة، تمخض عنها فيلم «ابن آوى»، وما يزال بجعبتها الكثير غيره.
أقدم ما يتناسب معي
لا تعارض فكرة مشاركة السيناريو مع كاتب آخر، فما الذي يسمه ليحمل عنك هذا العبء؟
إن توجهي السينمائي معروف، أفضل أن يكون النوع الذي أقدمه متناسباً معي فلا نكون طرفي نقيض.
كثيراً ما تقضّ مضجعنا الفجيعة التي تلم بشخصيات أفلامك، لماذا؟
النهايات دائماً مرتبطة بالبدايات، وبالتطور الدرامي للعمل، إلا أن الواقع المرير ما انفكّ يفرض نفسه في النهاية.
أوافق بكل سرور
تشهد الساحة الفنية في اليمن حراكاً إبداعياً حقق مراكز متقدمة وجوائز عالمية ضمن منافسات مختلفة على المسرح الدولي، أذكر ما أن الفيلم اليمني «عبر الأزقة» للمخرج اليمني يوسف الصباحي جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان هوليوود للأفلام العربية في لوس أنجلوس، كذلك فوز الفيلم الروائي «المرهقون» للمخرج عمرو جمال بجائزتين من منظمة العفو الدولية ومهرجان برلين السينمائي الدولي... فهل تفكر يوماً بالتعاون مع ممثلين أو صناع أفلام يمنيين؟
لعلّ قلة الإنتاج السينمائي اليمني لم تتح لي الفرصة كي أتابع السينما اليمنية، إلا أنني أوافق بكل سرور، خاصة إن كان التعاون مفيداً. أنا شخص محب لليمن وأحمل في جعبتي الكثير من الذكريات مع زملائي الطلاب اليمنيين إبان فترة دراستي في موسكو، أحدهم يحمل اسمي ذاته.
قدرة يمنية على صناعة المستقبل
كيف تعتقد أن صناعة السينما اليمنية يمكنها التغلب على التحديات التي تواجهها، كمحدودية الموارد والوصول إلى المنصات الدولية؟
أنا واثق بأن الشعب اليمني شعب موهوب وقادر على تأسيس أعمال مهمة في المستقبل، يتم ذلك عبر استثمار الإمكانيات المتوافرة لصناعة السينما، إضافة للتمويل واستقطاب الخبرات والتقنيات من الخارج.
منغصات الشهرة
لا بد في الختام من طلب نصيحة مبدعنا للشباب العربي الطموح، الذي غالباً ما يحاول صعود سلم النجاح السينمائي بكل أركانه دفعة واحدة...؟
كم تحيّرني هذه المسألة وتشعرني بالقلق، خاصة حين أرى أن جلّ أهدافهم تستجدي الظهور والشهرة التي لا يدركون منغصاتها الجمة!
لا ريب أنك عانيت من منغصات الشهرة!
الإحراج أكثر ما نابني. على سبيل المثال: بعد عرض فيلم «نسيم الروح»، بتُّ وزوجتي لنصحو على وقع باقات الورد في رواق المنزل، ذلك عدا عن الرسائل الواردة والخطابات والمخابرات الهاتفية... لعل لاريسا كانت متفهمة بطبعها ولم تظهر امتعاضاً صريحاً؛ لكن ذلك لا يروق لأي امرأة بكل تأكيد.

.jpg)








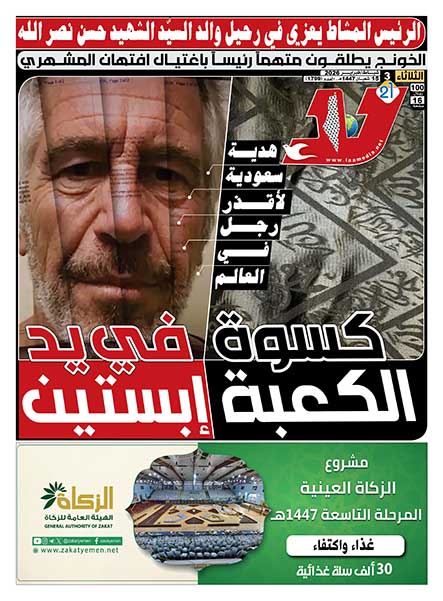
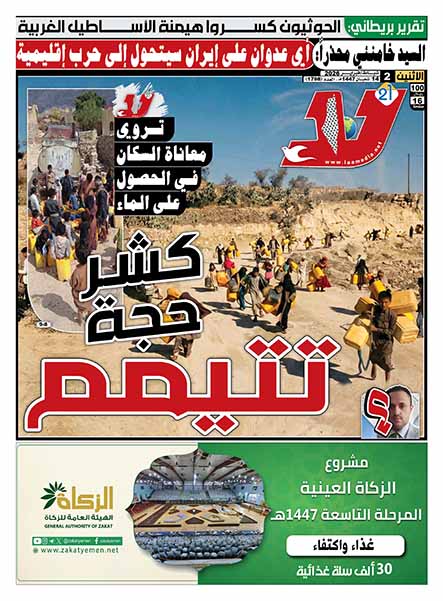






المصدر حنان علي / لا ميديا