الشاعر يحيى عوض الحداد:قيـد وصـلاة ممـيزة الطقـوس (الحلقة الأولى)
- تم النشر بواسطة مجاهد الصريمي / لا ميديا
.jpg)
مجاهد الصريمي / لا ميديا -
هو واحد من الشعراء الذين قدموا صورة حقيقية وصادقة عن الإنسان اليمني ومواجيده خلال النصف قرن الماضي، ويعد شاعرنا واحداً من الشعراء المهمين في تاريخ اليمن الأدبي كله، وهو واحد من مبدعي زبيد الذين تدل توهجاتهم الفنية على أن زبيد رغم كل ما نالها من تجفيف ومحو وزحزحة كاملة عن صفتها العظيمة كواحدة من الحواضر اليمنية التي مثلت مراكز إشعاع حضاري وعلمي وثقافي في تاريخ اليمن، لاتزال فيها عروق تنبض بالدماء وتفيض على كل من حولها بالحياة المعطاءة.
ولد شاعرنا يحيى عوض الحداد بمدينة زبيد سنة 1942 م وتلقى تعليماً نظامياً وصل به إلى الصف الرابع الابتدائي قبل أن يلتحق بالمدرسة العلمية في جامع الأشاعر، حيث كان من مشائخه فيها أحمد علي السادة وعبدالله بن زيد المعزبي، وتتلمذ أدبياً وإبداعياً على يد الشاعر الكبير عبدالله عطية، وارتبط كثيراً بخاله قاسم عمر محرقي حتى نسب إليه وعرف بين الناس في زبيد بلقب المحرقي لا بلقب الحداد، ومن خاله تعلم مهنة المحاماة، وهي لعمري مهنة اشتهر بها كثير من أدبائنا قبل أن يلمع صيتهم الأدبي، من أمثال نبي الشعر الأستاذ عبدالله البردوني، وهذا الشاعر أيضاً.
وقد كان خال شاعرنا يمارس مهنة المحاماة، وكان يمارس الوكالة في محاكم المتخاصمين، وقد دل على ذلك ما كتبه المؤرخ عبدالرحمن الحضرمي في كتابه "الحركة الأدبية في تهامة 1948-1990م"، أن الرجل كان من ذوي النبوغ المبكر، فقد برز في مهنة المحاماة وأجاد ممارستها وخبر خفاياها وتعقيداتها، أثّر ذلك على نفسيته، وفي ذلك نختلف مع الحضرمي، إذ إن المؤرخين والكتاب الأدبيين طالما يُرجعون تحيز الشاعر إلى مجتمعه وارتباطه بالمقهورين والمعذبين وتبنيه تطلعاتهم، إلى عقدة في نفس الشاعر أو احتدام ضغوط الحياة عليه، مما ينعكس سلباً على شخصه فيعيش صراعات محتدمة مع كل ما يحيط به.
وكما يقول الحضرمي: وكان نبوغه في المحاماة يتوازى مع نبوغه الشعري وتأهيله الثقافي والعلمي ليكون مدرساً بمدرسة الفوز بزبيد على شروط التعليم في ذلك الوقت لا على شروط التعليم اليوم، كل ذلك وهو في الـ17 من عمره.
حصل شاعرنا في ما بعد على معادلة من وزارة التربية والتعليم بليسانس في علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية.
وسمات يحيى عوض التي يعبر عنها ذكاؤه في التحصيل العلمي والثقافي ونبوغه الشعري المبكر، لا تنفصل عن سمات أخرى ارتبطت برحلته في الحياة والإبداع والنضال الوطني والجهاد التربوي، وأهم ما تميز به سمتان هما الحدة والميل إلى المواجهة، فقد لازم تكوينه الأول فلتات تمرد ووعي ثوري تقدمي طامح، وكان في أوج سن المراهقة حينما فر إلى عدن هارباً من أمر اعتقال أصدره في حقه والي الإمام على محافظة الحديدة بتهمة الشيوعية، وفي عدن انفتحت لشاعرنا آفاق جديدة، حيث تعرف على مجتمع ثقافي أكثر اتصالاً بالعالم، وانتُخِب عضواً في الهيئة الإدارية للاتحاد اليمني التي تشكلت بعد انسلاخها عن قيادة الزبيري والنعمان على إثر الحركة التي قادها علي محمد الأسودي والشاعر علي عبدالعزيز نصر وزملاؤهما ممن كانوا يؤسسون لحزب القوى الشعبية.
كما مارس شاعرنا التعليم في إحدى المدارس في عدن مدة تزيد عن سنتين قبل أن يعود إلى زبيد نهاية عام 1961م، وبعد أقل من عام وصل إلى صنعاء على رأس وفد من الشخصيات والأعيان التهامية، مهنئين رئيس الجمهورية الأول عبدالله السلال، مباركين ما استجد من تغيير نتج عن ثورة 26 سبتمبر، وقد ألقى الحداد قصيدة أمام الرئيس كان ملؤها المطامح والأحلام تتعامل مع سطح الظاهر ولا تستطيع النفوذ إلى أعماقه لترى ما يُخبأ للشعب من مكائد وما تنبني عليه الجواهر من خدعة سرعان ما اصطدم بها شاعرنا، وقد نالت هذه القصيدة رضى الرئيس عبدالله السلال، فأصدر أحمد المروني وزير الإعلام حينها أمراً بضمه إلى طاقم موظفي إذاعة صنعاء، لكنه لم يمكث فيها سوى أشهر حتى عاد مجدداً إلى زبيد.
الملاحظ هنا أن شاعرنا لم يصمد طويلاً في عدن حين ذهب إليها عام 1959، رغم ما كان يتوفر في عدن من ميزات مثالية لمبدع طامح مثله، كما أنه لم يصمد طويلاً في صنعاء بعد انضمامه لثوار 26 وعمله في إذاعة صنعاء، رغم ما كان يمكن أن توفره الإذاعة من شهرة له، ناهيك عن الفرص الكثيرة في المناصب والأسفار والتكريس الأدبي التي كان يفترض أن يحظى بها نابه مثله في ذلك الوقت، والسبب في عدم ميله لكل ذلك هو طبيعته التي تأنف الخضوع وتأبى أن تجعل من لسانها ممسحة لأحذية الطغاة، وتجعل من عقلها مرتعاً لمجاراة المفسدين، والتي تتخذ الرفض منطلقاً حقيقياً إلى ميدان رحب تتعارض فيه النفس السوية مع الضيم ولا ترغب بمداناته أو تقبل بالظلم والإجحاف، وهذا ما جعله يترك ما تركه من الفرص، وهنا تبدأ أولى صدماته بالواقع الجديد المحكوم بالتبعية والمليء بالظلم والتعسف، فأثناء عمله في الإذاعة كان عليه أن يغطي بثاً خارجياً للإذاعة
صباح العيد، وقد أمره سعد غزال مشرف الإذاعة المصري أن ينتقل إلى بث صلاة العيد بمجرد سماع ونانات موكب الرئيس الذي يقع خلف مبنى الإذاعة، ونفذ يحيى عوض المهمة، فما إن سمع الونانات حتى أعلن للمواطنين انتقال البث إلى الجبانة لنقل شعائر صلاة العيد التي تقام بحضور رئيس الجمهورية، وقام بالتغطية، ولكنه اكتشف أن صوت البث كان منعدماً تماماً، فلا يوجد سوى وشوشة الهواء، وراح ومعه آخرون يتفقدون أجهزة البث محاولين دون جدوى، فهم المشكلة واضطر حينها للاعتذار للمستمعين، وواصل بث البرنامج الإذاعي، وبعد ساعة من زمن البث فوجئ بصوت الجزمات العسكرية تهز الأرض وتركل أبواب الاستديوهات، فعرف أنهم جاؤوا بأوامر من الإدارة للقبض عليه، كان مدير الإذاعة وقتها الشاعر عبدالله حمران، وصدم يحيى عوض حين علم أن بانتظاره قيدين حديديين وأمراً صارماً "قيدوا أبوه"، فانفجر يحيى عوض ضاحكاً، سأله الآمر: لم تضحك؟ فأجاب يحيى عوض: لقد بح صوتي منذ الأمس وأنا أقرأ الدستور المؤقت "لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بعد محاكمة عادلة"، أريد على الأقل أن أعرف جريمتي.. صاح الآمر وقد انتفخت أوداجه وتطاير شرر الغضب من عينيه: لا بد من القيد.. "قيدوا أبوه"، وبعد أسبوع من سجنه استدعاه مدير الإذاعة ليعتذر له، فقد صادف لحظة انقطاع البث الخارجي صباح العيد اكتشاف محاولة انقلابية على الرئيس عبدالله السلال، وساد الاعتقاد عند القيادة أن المذيع يحيى عوض قطع البث عمداً لاشتراكه في تلك المحاولة الانقلابية، لكن الشك به تبدد بعد معرفة الإدارة أن ميكرفون الإذاعة كان متصلاً بخط تلفون مقطوع، وأن لا دخل له في ما حدث، ولكن محاولات مدير الإذاعة في الاعتذار له باءت بالفشل، وكما باءت بالفشل كذلك محاولات إقناعه بالبقاء مذيعاً بإذاعة صنعاء.
ظل شاعرنا يحيى عوض يتندر على هذه الحادثة ساخراً من الواقع الذي تفاجأ به: دخلت إذاعة صنعاء بقصيدة وخرجت منها بقيدين. نعم دخل بقصيدة إنها ذلك المكنون الذي اعتمل بأفكار الناس وظل يداعب أمانيهم وأحلامهم، وسرعان ما انقشعت حرارة القصيدة وروائحها النفاثة الناتجة عن شذا زهر القلوب الكادحة، ليجد اليمن وشاعره طريقاً بين قيدين وإن تنوعت وتعددت ماهية القيدين بين الشاعر وشعبه، إنها جملة تنبئ عن غرابة المفارقة التي تكشفت للشاعر خباياها تباعاً.
كثيراً ما ظُلِم شاعرنا من قبل تلك الأقلام القليلة جداً التي تناولته بالبحث والدراسة، فأحدهم يرجع عدم تصالحه مع الأنظمة المتعاقبة إلى عقدة في نفسه، وآخر يرجعها إلى انتمائه لتيارات يسارية تبنت الثورية والصدامية وطُبِعت على ذلك، إذ إن كل باحث حين يبحث ظاهرة شعرية لا يرى إلا بتلك العين التي انحصرت في عالم الرؤيا من حولها على النظام الحاكم الذي يغدق عليها من عطاياه ويجعلها عماداً من أعمدة تثبيت حكمه، وينطلق بها بضاعة إلى أسواق المجتمع ليغطي من خلالها سوأته ويضخم بها عرشه المتهالك من الداخل.
إن تمحيصك عزيزي القارئ لكل ما كتب في تاريخنا الأدبي القديم والمعاصر، يجعلك تدرك أن ذلك المداد المنساب على الصفحات ليس سوى مسحوق تجملت به وجوه الطغاة القبيحة لعقود من الزمن، أما الناطقون بالحقيقة والعاملون بمقتضى تثبيتها في وجدان الناس، فهم قليلون وقليلون جداً.

.jpg)



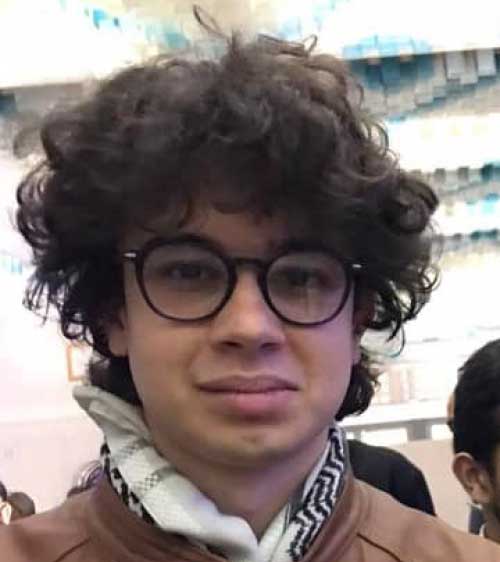




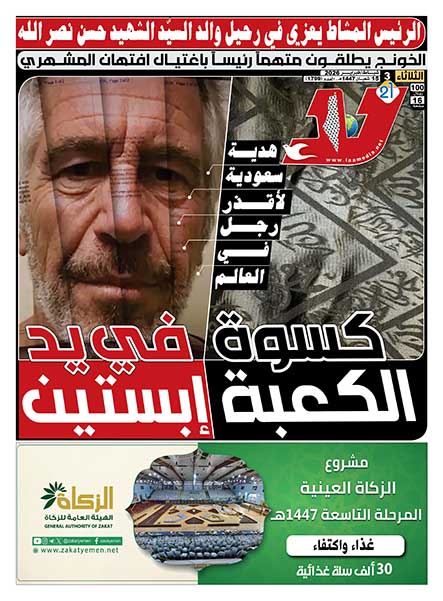
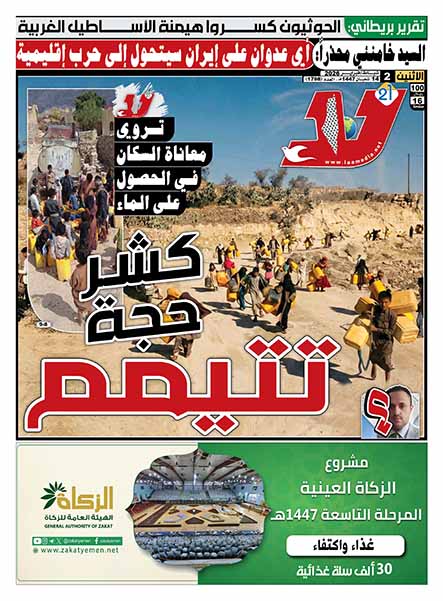






المصدر مجاهد الصريمي / لا ميديا