عودة العقوبات الغربية على طهران وخيارات الرد الإيراني
- أنس القاضي السبت , 11 أكـتـوبـر , 2025 الساعة 2:00:14 AM
- 0 تعليقات

أنس القـاضي / لا ميديا -
أولاً: خلفية التطور
شهد الملف النووي الإيراني، في السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2025، محطة فارقة، تمثلت في إعلان دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) تفعيل ما يُعرف بـ"سناب باك"، أو "آلية الزناد"، وهي الآلية التي تتيح العودة التلقائية إلى عقوبات مجلس الأمن الدولي التي كانت قد رُفعت بموجب اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة الموقَّعة عام 2015. هذا القرار الأوروبي لم يأتِ بمعزل عن سياق الضغوط الأمريكية المستمرة، بل يعكس بوضوح استمرار الغرب في استخدام المؤسسات الدولية أداة للابتزاز السياسي والاقتصادي ضد الدول التي تنتهج مساراً سيادياً مستقلاً، وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تمثل ركيزة أساسية لمحور المقاومة في المنطقة.
الخطوة الأوروبية جاءت بعد فشل مبادرة (روسية - صينية) كانت تهدف إلى تمرير قرار في مجلس الأمن يمدّد المهلة التقنية لتنفيذ القرار (2231) لستة أشهر إضافية، بما يمنح مساحة تفاوضية أوسع ويحول دون الانزلاق إلى المواجهة. إلا أن الرفض الغربي لهذه المبادرة، وعرقلتها، عبر استخدام ثقلها داخل المجلس، يكشف عن إصرار على إعادة فرض الوصاية على البرنامج النووي الإيراني وإبقائه تحت سقف القيود الغربية، في ظل إدراكهم المتزايد أن إيران استطاعت خلال السنوات الماضية تطوير قدراتها التقنية بشكل لافت، وخصوصاً في مجال التخصيب وإنتاج الصواريخ والمسيّرات.
من الناحية القانونية والسياسية، فإن تفعيل "السناب باك" يعيد إيران -وفق التصور الغربي- إلى ما قبل عام 2015، أي إلى وضع الدولة المقيّدة بكامل قرارات مجلس الأمن. غير أن طهران ترى في هذه الخطوة إجراءً فاقداً للشرعية، ويتعارض مع نصوص القرار (2231) ذاته، ومع روح التفاهمات التي جرى التوصل إليها بعد مفاوضات مضنية استمرت أكثر من عقد. وبذلك، فإن إعادة فرض العقوبات لا تعكس فقط صراعاً تقنياً حول نِسب التخصيب أو مستويات الرقابة، بل تعبّر عن إرادة سياسية غربية لإبقاء إيران مكبّلة ومنعها من الاستفادة من موقعها الجيوسياسي وقدراتها العلمية والصناعية في بناء استقلالها الوطني وتعزيز حضورها الإقليمي.
ثانياً: مضمون العقوبات المُعادة
إعادة العقوبات، وإن جرى تسويقها في الإعلام الغربي تحت غطاء "الشرعية الدولية" و"حماية نظام منع الانتشار النووي"، إلا أنها في جوهرها تأتي استمراراً لنهج الحصار الاقتصادي والسياسي الذي طالما استخدمته القوى الغربية لإضعاف الدول المناهضة لهيمنتها.
تشمل العقوبات التي أعيد فرضها حظراً شاملاً على تصدير واستيراد السلاح إلى إيران، وهو إجراء لا يمكن عزله عن سياق محاولة الغرب حرمان محور المقاومة من التطور الطبيعي في قدراته الدفاعية، خصوصاً بعد أن أثبتت التجربة الميدانية -في فلسطين واليمن ولبنان- أن الأسلحة الإيرانية، التقليدية منها والمطورة محلياً، قلبت موازين الردع في غير صالح الاحتلال "الإسرائيلي" وحلفائه.
كذلك، تعيد العقوبات فرض قيود مشددة على أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، بما في ذلك أي نشاط يتصل بتطوير الصواريخ الباليستية والمسيّرات. وبذلك يتضح أن الغرب لا يستهدف "الملف النووي" بمعناه الضيق، بل يسعى إلى خنق مجمل القدرات التقنية التي تمكّن إيران من تثبيت موقعها كقوة إقليمية صاعدة.
إلى جانب ذلك، تنص العقوبات على تجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة ببرنامج إيران النووي والصاروخي، إضافة إلى فرض قيود سفر على مسؤولين سياسيين وعسكريين.
مثل هذه الإجراءات، رغم أنها تبدو ذات طابع رمزي في بعض أبعادها، إلا أنها تكشف عن محاولة لتجريم مؤسسات الدولة الإيرانية وشيطنتها أمام الرأي العام الدولي، بما يخدم السردية الغربية الساعية إلى عزل إيران سياسياً واقتصادياً.
لكن في المقابل، ورغم كل ما تحمله هذه العقوبات من قيود شكلية، يبقى تأثيرها العملي موضع جدل. فإيران استطاعت على مدى سنوات الحصار الطويلة تطوير منظومة واسعة من العلاقات التجارية مع شركاء آسيويين وأفارقة ولاتينيين، وابتكار قنوات التفاف على العقوبات الغربية.
وعليه، فإن العقوبات المُعادة ليست مجرد نصوص قانونية في قرارات أممية، بل تمثل ساحة جديدة من ساحات الصراع بين مشروعين متناقضين: مشروع غربي يحاول عبر "الشرعية الدولية" تكريس نظام تبعية وهيمنة، ومشروع إيراني مقاوم يرى في الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرات الدفاعية والاقتصادية خياراً وجودياً لا رجعة عنه.
ثالثاً: الموقف الإيراني
أظهرت طهران، في أعقاب إعلان الترويكا الأوروبية إعادة تفعيل "آلية الزناد"، موقفاً مركّباً يجمع بين لغة التحدي والسيادة من جهة، وإبقاء الباب مفتوحاً أمام المناورة الدبلوماسية من جهة أخرى.
فمنذ اللحظة الأولى، تعاملت الجمهورية الإسلامية مع القرار بوصفه إجراءً فاقداً للشرعية، بل اعتبرته انتهاكاً سافراً للقرار (2231) الذي أنهى العقوبات السابقة، وخرقاً واضحاً للتفاهمات التي أسس لها الاتفاق النووي لعام 2015. وفي هذا السياق، أكدت الخارجية الإيرانية أن أي محاولة لإحياء العقوبات الملغاة تمثل استغلالاً سياسياً لمؤسسات الأمم المتحدة، وأن الجمهورية الإسلامية سترد "رداً حازماً ومناسباً"، دفاعاً عن حقوقها السيادية ومصالح شعبها.
داخلياً، انعكس الموقف في نقاشات البرلمان، الذي شهد جلسات مغلقة لبحث الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، وهو مؤشر إلى أن إيران تريد إظهار امتلاكها لخيارات استراتيجية مفتوحة، بما في ذلك مراجعة التزاماتها القانونية الدولية إذا ما تمادت القوى الغربية في استغلال هذه الالتزامات لفرض الإملاءات.
إلا أن القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس مسعود بزشكيان، حرصت على التوضيح أن طهران لا تزال ملتزمة -مبدئياً- بإطار المعاهدة، وأن وجود المفتشين الدوليين في المنشآت النووية يمكن أن يستمر ضمن حدود معينة، شريطة ألا يتحول إلى أداة ابتزاز سياسي. بهذا المعنى، فإن الموقف الإيراني يوازن بين إظهار الجدية في حماية السيادة، وإبقاء جسر التفاوض قائماً لتفادي اصطفاف دولي شامل ضدها.
أما على المستوى الخطابي، فقد شدد المرشد الأعلى، السيد علي خامنئي، على رفض أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، انطلاقاً من قناعة بأن واشنطن لا تتعامل بجدية، وأنها تستخدم لغة التفاوض كغطاء لتعميق الضغوط.
وفي المقابل، حملت تصريحات الرئيس بزشكيان ونخب سياسية أخرى رسائل مزدوجة: تحميل واشنطن المسؤولية عن إفشال أي اتفاق محتمل، والتأكيد على استعداد طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات إذا ما توفرت ضمانات حقيقية لرفع العقوبات، لا مجرد وعود مؤقتة.
إن الموقف الإيراني في جوهره يعكس خبرة تراكمت على مدى عقدين من الصراع مع الغرب؛ خبرة تقوم على الجمع بين إظهار الصمود والتحدي من جهة، وإبقاء مساحة للمناورة الدبلوماسية من جهة أخرى؛ فطهران تدرك أن الخضوع للابتزاز سيفتح شهية الغرب لمطالب إضافية تمس جوهر سيادتها؛ لكنها، في الوقت نفسه، لا تريد أن تُدفع إلى زاوية العزلة الدولية الكاملة. وعليه، يمكن القول إن الموقف الإيراني يترجم فلسفة "التصعيد المدروس": تشديد المواقف ميدانياً ونووياً بما يرفع كلفة الضغوط الغربية، دون حرق جسور الحوار التي قد تسمح بانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية لاحقاً.
رابعاً: المواقف الدولية
أظهرت التفاعلات الدولية حيال إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران انقساماً واضحاً بين معسكرين متقابلين: الأول غربي بقيادة الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية"، والثاني تقوده روسيا والصين ويجد صداه لدى قوى إقليمية وشعوب ترى في هذه العقوبات امتداداً لسياسة الكيل بمكيالين في النظام الدولي.
في المعسكر الغربي، كان الموقف الأمريكي الأكثر وضوحاً؛ إذ رحبت واشنطن بخطوة "الترويكا" واعتبرتها دليلاً على "القيادة العالمية" لأوروبا في مواجهة إيران. غير أن الخطاب الأمريكي حمل تناقضاً بين التشدد السياسي والمرونة الشكلية؛ فالبيت الأبيض ووزارة الخارجية أكدا أن "الدبلوماسية ما تزال الخيار الأفضل"؛ لكن ضمن شروط مجحفة تُعيد النقاش إلى نقطة الصفر، أي: ضرورة توسيع المفاوضات لتشمل الملف الصاروخي والسياسة الإقليمية الإيرانية.
هذا الخطاب يعكس بجلاء استراتيجية واشنطن المزدوجة: تصعيد العقوبات لإضعاف إيران ومحورها، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً كأداة ضبط لا كخيار جاد لتسوية عادلة.
أما أوروبا، فإن موقف "الترويكا" (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) جاء متماهياً مع الرؤية الأمريكية، وإن حاولت صياغته بلغة دبلوماسية أقل حدة؛ فقد برر وزراء الخارجية الأوروبيون تفعيل "آلية الزناد" بأنه "خطوة قانونية" لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، مؤكدين في الوقت نفسه أن العقوبات ليست نهاية الدبلوماسية، بل وسيلة لفرض العودة إلى التزامات 2015.
لكن القراءة الواقعية تكشف أن هذا الموقف يندرج ضمن منطق الهيمنة، أي: فرض قيود جديدة دون تقديم ضمانات برفع العقوبات أو الاعتراف بحق إيران في الاستخدام السلمي الكامل للطاقة النووية، وهو ما يعزز الانطباع بأن أوروبا، رغم خطابها عن "الاستقلالية الاستراتيجية"، لا تزال تتحرك ضمن المدار الأمريكي.
في المقابل، وقفت روسيا والصين موقفاً رافضاً لما جرى، معتبرتين أن تفعيل آلية الزناد فاقد للشرعية ويمثل خرقاً صريحاً للقرار (2231). فموسكو وبكين كانتا قد تقدمتا بمشروع قرار يمنح تمديداً تقنياً للاتفاق؛ لكن إسقاطه بالتصويت كشف حجم اختلال التوازنات داخل مجلس الأمن.
تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، جاءت لافتة؛ إذ وصف "آلية الزناد" بأنها أداة غير أنيقة صُمّمت لإبقاء إيران تحت الضغط الدائم، فيما أكدت بكين أن هذه الإجراءات تقوّض النظام متعدد الأطراف وتكشف عن تسخير القانون الدولي لخدمة أجندة ضيقة.
إلى جانب هذه المواقف الرسمية، رحّب "الكيان الصهيوني" بالقرار، واعتبره "تطوراً مهماً"، في محاولة لاستثماره ضمن خطابه التقليدي الذي يصوّر إيران كتهديد وجودي، ويبرر استمرار الدعم العسكري الغربي للمشروع الصهيوني.
إجمالاً، يمكن القول إن المواقف الدولية كرّست معادلة قائمة: الغرب يسعى لفرض وصايته عبر المؤسسات الأممية، في حين تتمسك روسيا والصين ومعهما قوى المقاومة بضرورة مواجهة هذا النهج الأحادي.
هذه الثنائية تعكس بدورها الصراع الأوسع حول شكل النظام الدولي المقبل: بين نظام هيمنة أمريكية متراجعة، ومحاولات قوى صاعدة لتكريس تعددية قطبية تمنح إيران ومحور المقاومة مساحة أوسع للتحرك السياسي والاستراتيجي.
خامساً: خيارات إيران المتوقعة
أمام إعادة فرض العقوبات الأممية ومحاولة الغرب إغلاق الهامش السياسي والاقتصادي أمامها، تجد الجمهورية الإسلامية نفسها أمام مجموعة من الخيارات الاستراتيجية التي تُبنى على قاعدة مزدوجة: تعزيز الردع وتثبيت السيادة من جهة، وإبقاء هامش المناورة الدبلوماسية من جهة أخرى. هذه الخيارات لا تنفصل عن خبرة إيران التاريخية في مواجهة الضغوط، وعن مكانتها كقوة مركزية في محور المقاومة.
1. التصعيد النووي المراقَب: من المرجّح أن تتجه طهران نحو تعميق الغموض الاستراتيجي في ملفها النووي، عبر تقليص مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيادة نسب التخصيب في حدود لا تصل إلى الانسحاب الكامل من معاهدة عدم الانتشار. هذه الخطوة تمنح إيران ورقة ضغط إضافية على الغرب، وتُبقي في الوقت نفسه جسر التفاوض قائماً، بحيث يمكن استخدام التراجع التكتيكي في المستقبل كأداة مقايضة مقابل رفع ملموس للعقوبات.
2. الضغط عبر الحلفاء: يبقى أحد خيارات إيران هو الضغط على الولايات المتحدة بالحلفاء من قوى المقاومة ضمن إطار محسوب. هذا التحريك لا يعني بالضرورة الذهاب إلى مواجهة شاملة، بل تكثيف الرسائل النارية والعمليات المحدودة التي تُظهر أن الضغط على إيران سيقابله توتر في الجبهات المتصلة بمصالح الغرب وحلفائه.
من هذا المنظور، يصبح البحر الأحمر والخليج، إضافة إلى جبهة فلسطين ولبنان، ساحات ضغط متوازية تُستخدم لتذكير الخصوم بأن كلفة العقوبات ليست محصورة داخل حدود إيران، ومع ذلك فمن المهم الأخذ بعين الاعتبار أن حلفاء إيران من قوى المقاومة في وضع غير مريح، سواء في لبنان أو العراق أو فلسطين، وتبقى اليمن كدولة هي الحليف الأقوى لإيران ضمن محور المقاومة.
3. تعزيز سياسة الاكتفاء الذاتي: إحدى أبرز استراتيجيات طهران التي أثبتت فاعليتها خلال سنوات الحصار الطويلة هي الاستثمار في القدرات الوطنية وتوسيع الشراكات مع القوى غير الغربية، من الصين وروسيا إلى بلدان أميركا اللاتينية وأفريقيا.
هذا الخيار ليس رداً تكتيكياً فقط، بل يمثل مساراً بنيوياً يتماشى مع رؤية إيران لنظام عالمي متعدد الأقطاب، ويحوّل العقوبات من أداة خنق إلى دافع لتعزيز التصنيع المحلي والاستقلال الاقتصادي.
4. إبقاء جسر التفاوض قائماً: رغم الخطاب المتشدد، تدرك القيادة الإيرانية أن إبقاء نافذة الحوار مفتوحة يخدم مصالحها الاستراتيجية؛ فإيران لا تسعى إلى عزل نفسها دولياً، بل إلى فرض معادلة جديدة للتفاوض: رفع العقوبات مقابل قيود مدروسة على التخصيب والصواريخ، لا مقابل الخضوع الكلي. هذا الخيار يعكس براغماتية إيرانية تهدف إلى تحويل الضغط إلى فرصة لمقايضة محسوبة، دون التنازل عن جوهر السيادة أو أدوات الردع.
5. الضغط السياسي: من المتوقع أن تستمر إيران في خطابها السيادي الحاد ضد الغرب، مرفقاً بخطوات رمزية (مثل نقاش الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، أو التلويح بتقليص التعاون مع الوكالة الدولية). هذه الخطوات تهدف إلى رفع كلفة أي تصعيد غربي إضافي، وتعزيز صورة إيران أمام شعوب المنطقة كدولة تقف في مواجهة الهيمنة.
سادساً: التداعيات الإقليمية
لا يمكن النظر إلى إعادة فرض العقوبات على إيران باعتبارها شأناً داخلياً أو تقنياً يقتصر على الملف النووي، بل هي خطوة ذات انعكاسات مباشرة على الإقليم ككل، خاصة أن إيران تمثل ثقل محور المقاومة، وتحيط بها المصالح الغربية والأمريكية من كل جانب، وبالتالي فمنطقي أن أي محاولة لاستهدافها بالضغط أو الحصار تنعكس تلقائياً على ساحات المواجهة المرتبطة بها.
اليمن والبحر الأحمر
في الساحة اليمنية، وفي حالة كان هناك توافق يمني إيراني على التصعيد، يُتوقع أن تعود التوترات بشكل أكبر في البحر الأحمر على خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
لبنان وفلسطين
على الجبهة اللبنانية - الفلسطينية، يظل احتمال التصعيد وارداً؛ لكن قوى المقاومة في وضع غير جيد، في غزة وجنوب لبنان. قد يقوم حزب الله في حال وجد أنه قادر على ذلك رسائل ردع، دون الانزلاق إلى حرب شاملة، إدراكاً لحساسية الظرف المحلي والإقليمي.
العراق
في العراق، قد نشهد تحريكاً مدروساً لبعض الفصائل المقاومة، لإظهار أن النفوذ الأمريكي العسكري والسياسي عرضة للاهتزاز في حال واصل الغرب سياسة الخنق الاقتصادي ضد إيران.
الخليج العربي
أما بالنسبة لدول الخليج فإن إعادة فرض العقوبات تضعها أمام معادلة جديدة؛ فمن جهة، ستسعى السعودية والإمارات إلى الاستفادة من الضغط الغربي على إيران، لتعزيز موقعهما التفاوضي معها؛ لكن من جهة أخرى يدركان أن التصعيد قد يهدد أمنهما المباشر عبر استهداف منشآتهما النفطية أو ممراتهما البحرية. هذا التوازن سيجعل دول الخليج أكثر حذراً، وربما أكثر استعداداً للدخول في ترتيبات أمنية جديدة تأخذ في الاعتبار حضور إيران الإقليمي.
التقدير العام
يمثّل تفعيل آلية الزناد من قِبل الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) لحظة فارقة في مسار الصراع الدولي حول البرنامج النووي الإيراني؛ إذ يعيد الغرب استخدام أدوات "الشرعية الدولية" لتكريس وصايته على الدول المستقلة، وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه الخطوة لم تأتِ بمعزل عن الضغوط الأمريكية، بل تعكس إصراراً غربياً على إبقاء إيران مكبّلة سياسياً واقتصادياً، في الوقت الذي أثبتت فيه التجربة الميدانية أن قدراتها العلمية والصاروخية والمسيّرات أسهمت في قلب موازين الردع لصالح محور المقاومة في فلسطين واليمن ولبنان.
في المقابل، يُظهر الموقف الإيراني تماسكاً مبنياً على فلسفة "التصعيد المدروس": الجمع بين الصمود والتحدي السيادي من جهة، وبين إبقاء قنوات المناورة الدبلوماسية مفتوحة من جهة أخرى. فإيران تدرك أن الانخراط الكلي في مواجهة مفتوحة قد يعرّضها لمخاطر عزلة دولية؛ لكنها أيضاً تدرك أن أي خضوع للابتزاز الغربي سيقود إلى مزيد من القيود. ومن هنا، تبني استراتيجيتها على تنويع الخيارات: التصعيد النووي المراقب، الضغط عبر الحلفاء، تعزيز الاكتفاء الذاتي، وإبقاء جسر التفاوض قائماً وفق معادلة "رفع العقوبات مقابل قيود مدروسة"، لا مقابل الخضوع الكلي.
أما على المستوى الدولي، فإن الانقسام الحاد بين الغرب من جهة وروسيا - الصين من جهة أخرى يكشف عن عمق التحولات في النظام الدولي. الغرب يصرّ على إعادة إنتاج أحادية القطبية تحت غطاء القانون الدولي، فيما تسعى القوى الصاعدة، ومعها قوى المقاومة، إلى ترسيخ ملامح عالم متعدد الأقطاب، يمنح الدول المستقلة مساحات أوسع للحركة والسيادة.
انعكاس هذه التطورات لن يقتصر على إيران وحدها، بل سيمتد إلى ساحات المواجهة كافة في المنطقة. فاليمن، بقدراته المتنامية في البحر الأحمر، يشكل حليفاً قوياً لإيران في معادلة الردع، وقد يسند إيران إذا انهار الوضع، فيما تبقى فلسطين ولبنان والعراق ساحات ضغط أضعف، لانشغال قوى المقاومة بظروفها المحلة الصعبة.
كذلك فإن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، تجد نفسها أمام معادلة أمنية معقدة بين الرغبة في الاستفادة من الضغط الغربي على إيران، والخشية من أن يؤدي التصعيد إلى تهديد مباشر لبنيتها النفطية والأمنية.
الخاتمة
إن إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران معركة سياسية كبرى تُلخّص جوهر الصراع بين مشروعين: مشروع غربي يسعى إلى فرض التبعية والهيمنة، ومشروع مقاوم - إيراني يتمسك بالسيادة الوطنية وبناء القوة الذاتية والانخراط في نظام عالمي متعدد الأقطاب. وفي هذا السياق، تبدو طهران في موقع "المبادر" لا "المدافع"، فهي لا تواجه الضغوط فقط بل تحوّلها إلى فرص لتوسيع شراكاتها، تعميق استقلالها، وتكريس دورها المحوري في معادلة الردع الإقليمي.
وعليه، فإن تقدير الموقف العام يؤكد أن خطوة الترويكا الأوروبية ستؤثر على إيران اقتصادياً في الداخل؛ لكنها لن تضعفها على الصعيد الاستراتيجي، وسوف تدفع نحو تنسيق أكبر بين قوى المقاومة. وكذلك بين الدول الصديقة لإيران التي ترفض الهيمنة الغربية، بما يجعل العقوبات سلاحاً مزدوجاً يرتد على الغرب نفسه.

.jpg)








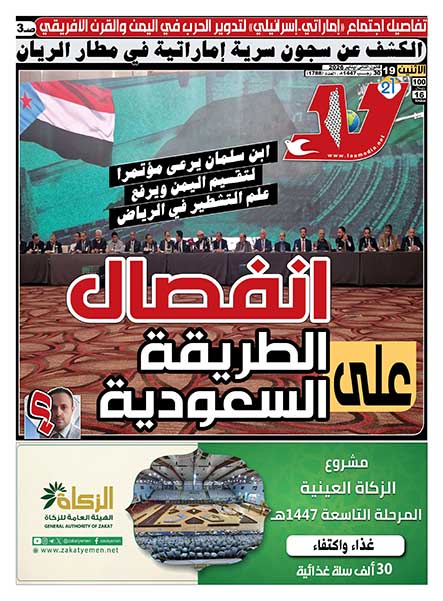





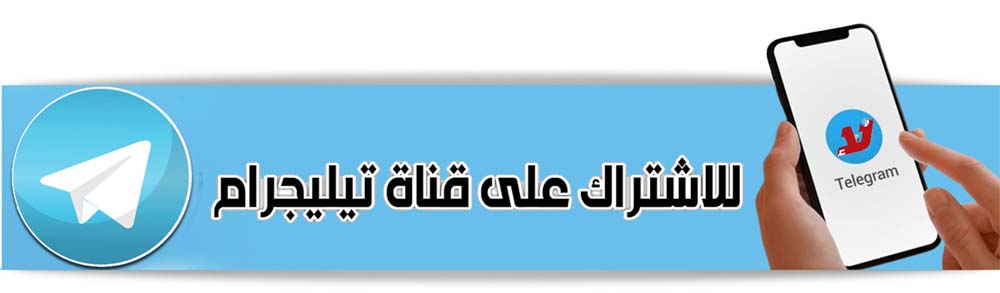
المصدر أنس القاضي
زيارة جميع مقالات: أنس القاضي