حدثان في طفولتي
- محمد القيرعي الأثنين , 13 أكـتـوبـر , 2025 الساعة 1:20:54 AM
- 0 تعليقات
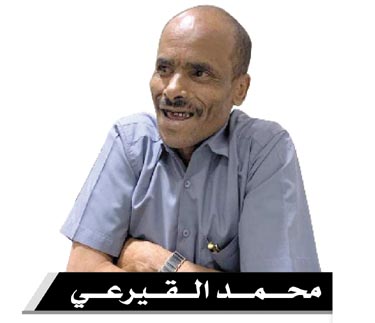
محمد القيرعي / لا ميديا -
(كل ما هو أسود مقدس. ولا نامت أعين الجبناء).
حدثان عنصريان عصفا بي في طفولتي، كان لهما الأثر الحاسم في تكوين تركيبتي الشخصية، وفي تعزيز إيماني المطلق واللامتناهي بالإنسانية (كعقيدة ذاتية راسخة) تتعدى بكثير من حيث قدسيتها حدود مجمل التخيلات اللاهوتية.
حدثان لا يزالان عالقين في مخيلتي بكل تفاصيلهما الدقيقة والمضنية والمؤلمة، رغم مضي خمسة عقود كاملة على حدوثهما.
كنت حينها في الخامسة من عمري، حوالى العام 1972، حين بدأت باختبار وتجرُّع مرارة الامتهان العنصري بكل سوءاته (كعورة أخلاقية) وبشكل فعلي ودقيق ومباشر؛ حين رافقت والدتي كطفل إلى حفلة عرس في قرية «حصبرة» المحاذية لمدينة التربة من جهة الجنوب، رغم أن التربة ذاتها كانت آنذاك لا تزال في طور النمو المديني، بحيث لا تتعدى ديمغرافيتها الحضرية حدود القرية الكبيرة نوعاً ما.
كان العرس مقاماً في منزل قبيلي كهل يدعى محمد الفقيه، وكان يحظى باحترام وتقدير الجميع (سود وبيض) على حد سواء، نظراً إلى طيبة قلبه ودماثة أخلاقه وتواضعه الجم مع كل من حوله.
كانت والدتي حينها واحدة من ثلاث أو أربع مغنيات مهمشات منهمكات بإحياء الحفل النسائي بالغناء البلدي المسمى «الشرح» المصحوب عادة بإيقاع «المرفع» والدف.
وفي خضم الهرج والمرج النسائي، اضطررتُ إلى الوقوف في طرف الغرفة (غرفة الرقص والشرح) وعند بابها الرئيسي تحديداً، المطل على فناء الدار، الذي يحوي أيضاً الممر المؤدي للدور العلوي حيث تجمع الضيوف من الذكور -القبائل- في جلسة المقيل المعتادة في مثل هذه المناسبات.
وفي لحظة ما، وفيما كنت أقف قرب باب غرفة الحريم، لمحت أحد الضيوف القبائل يهبط الدرج مغادراً. وبشكل تلقائي قمت بإغلاق الباب، حرصاً على عورات وحرمات «ستاتي القبيليات»، لكيلا يقع نظره عليهن وهن باللباس العاري والزينة المستخدمة بإفراط كما هو الحال في مثل هذه المناسبات. انطبق مزلاق الباب دون قصد مني على يد طفل قبيلي كان بمعية والدته، والذي علا صراخه وعويله، رغم أنه لم يصب بأذى بدني جراء الحادثة، ولتهرع والدته من جهتها كالمسعورة لتعتدي عليَّ بالضرب الوحشي دون أن تكلف نفسها حتى عناء الاستفسار عما حدث. ظلت تضربني بيديها الاثنتين على ظهري وعلى وجهي بقسوة غير معتادة، مصحوبة بصراخها التفوقي والهستيري على شكل «مهجل بلدي»، بما معناه: «خادم ضرب سيده، خادم ضرب سيده». وأمام أعين والدتي وقريباتي المهمشات اللواتي لم يحاولن حمايتي منها ولم ينبسن ببنت شفة، إلى أن توقفت تلك المرأة عن ضربي من تلقاء نفسها، بعد أن شفت غليلها بالطبع، رغم أن مبادرتي بإغلاق الباب كانت مدفوعة -كما أسلفت- بحرصي على ألا يرى القبيلي المار من أمام الباب عورتها هي وبقية الضيفات من جنسها، أقصد القبيليات.
الحادثة الأخرى وقعت بعدها بأيام قلائل، ومن قبل سيدة بيضاء مسنة (تدعى «نميم»)، وفي القرية نفسها تحديداً (حصبرة). كانت قد طلبتني لتزويدها بالماء من البركة خاصتها الواقعة في فناء الدار إلى حمامات الدور العلوي. وبما أنني طفل في الخامسة من عمري فقد كان حمل جالون ماء سعة خمسة لترات يشكل عبئاً بدنياً مضاعفاً عليَّ، الأمر الذي أعاقني عن إنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة، لأفاجأ أثناء نقلي للماء بشقيق صاحبة الدار (عبدالله الذبحاني) يرسل في استدعاء والدي وهو يتقد غضباً على ضوء اتهامات شقيقته «نميم» لي بسبها والتقليل من شأنها أثناء مخاطبتي لها، رغم أن ذلك لم يحدث البتة. أقسم على ذلك بدموع أطفال الصفيح وأنين الثكالى السمراوات.
فما كان من أبي إلا أن عرضني عارياً أمامهم وسط فناء الدار وعلى مرأى من أهل القرية وانهال عليَّ جلداً بعصا غليظة (صميل إن جاز التعبير)، وبشكل وحشي، حتى ارتضوا (أي السيدة وشقيقها) بعد أن تورم بدني من أثر الضرب، بحيث لم يكن لأنيني ولا لدموعي وإنكاري وتوسلاتي أي معنى أو قيمة تذكر في هذا الشأن.
فالقبيلي دائماً على حق؛ لأنه مخلوق على هيئة الرب، مثلما لم يكن بيد والدي حيلة بالطبع. فإفراطه بضربي وبتلك القسوة والوحشية التي أقعدتني عن الحركة لأيام عدة، كان هو الإجراء المنطقي والسليم من منظوره الشخصي، سواء كنت مذنباً أم بريئاً، وذلك بغية الحفاظ على روابط العبودية مع أسياده القبائل، باعتبارهم أحد مصادر عيشه وأبنائه الشحيحة والمستديمة.
لم أكن حينها قد التحقت حتى بالصف الأول الابتدائي؛ إذ كنت لا أزال في معلامة القرآن، أتلقى وبتفوق مشهود لي حينها علوم القرآن والدين الداعي نظرياً للمساواة، وعبر الألواح الخشبية المستخدمة في تلك الحقبة عوضاً عن الدفاتر الورقية التي كانت متداولة في المدارس النظامية فقط.
مذاك كفرت بعلوم الدين ومجتمعها الأبيض، كفراً بواحاً حتى النخاع، كفراً لن يفارقني حتى اللحظة الأخيرة من حياتي.
اليوم، وبعد مضي خمسة عقود ونيف على تينك الحادثتين، لا يزال النّظام الاجتماعي العنصري المقيت والموروث ذاته هو حجر الزاوية الذي تأسّست عليه الهيكليّة السياسيّة والتشريعيّة وحتى القانونية النافذة والمعطلة منها على امتداد مراحل العملية الثورية في البلاد.
لعل هذا هو ما أبقى على هذين الحدثين حيين وحاضرين في مخيلتي طوال هذه المدة، وكأنهما حدثا في الأمس القريب، للتدليل ربما على مدى البغض والبربرية التي ما زالت تعكس قيم هذا المجتمع الماضيوي المأزوم، بكل فئاته وطوائفه وعشائره المبندقة والمتعثرة خارج نطاق الحضارة والتحضر الإنساني بصورة لا أمل في شفائه منها.

.jpg)










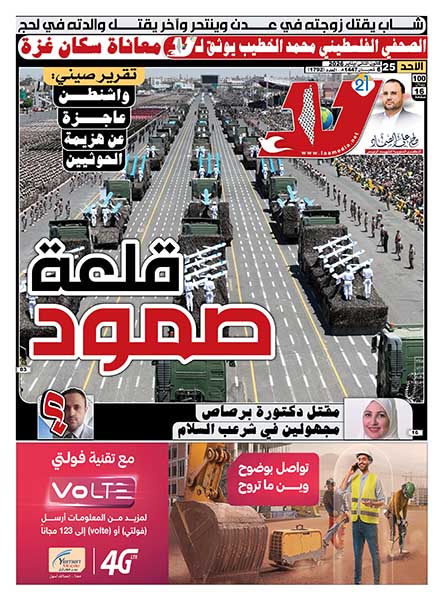
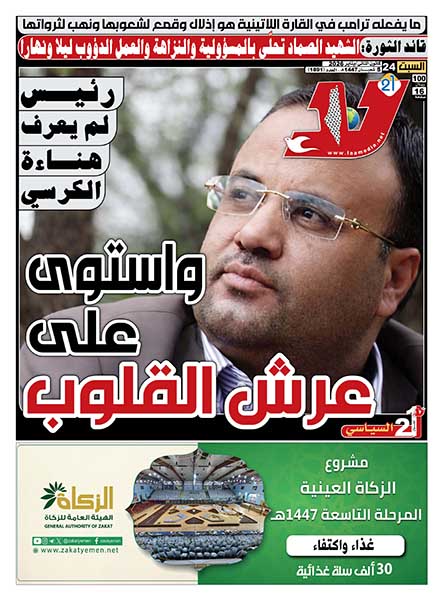


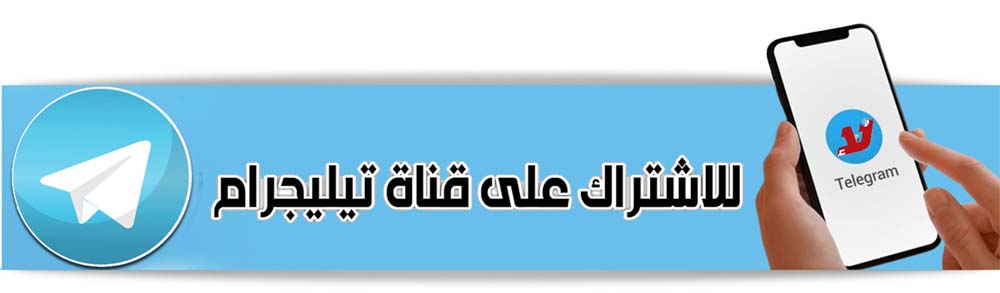
المصدر محمد القيرعي
زيارة جميع مقالات: محمد القيرعي