الكتابة كإرجاء وممحاة لقسوة الذاكرة ...في «أطياف عدن - هذيان الحطب - شهادات سياسية» الحلقة الثانية
- محمد ناجي أحمد الأثنين , 22 يـولـيـو , 2019 الساعة 7:04:57 PM
- 0 تعليقات

محمد ناجي أحمد / لا ميديا -
لن تستعاد "عدن المستحيلة" -بحسب الكاتب- إلاَّ من خلال جيل "انتظار الجيل المستحيل"، أي من خلال المهدي المنتظر بسماته الجماعية كجيل خارق ينتمي إلى الغيب! "لن تستعاد عدن المستحيلة، المتخيلة، بأية حذافير سابقة، وهي ليست في انتظار أصحاب السوابق. الأرجح أن عدن في انتظار تخليق الجيل المستحيل من أحشائها، لإنجاز مهمة إعادة اكتشافها واختراعها، وذلك ليس بغريب عليها". وهكذا نرتمي في التمنيات المخدرة والمطمئنة، في رشوة للضمير المستكين، فهناك جيل متخيل، كما أن هناك مدينة متخيلة، في يوتوبيا تنتمي نسقاً ولغة لعالم الوحي والزعامة التي نفى الكاتب اتسامه بصفاتهما.
ينتقد الكاتب ما وصفه بـ"التبييض السياسي" للوجوه الكالحة، الذي "جعل من الصعب الحديث عن طيّ صفحة الماضي، أو استعادة ثقة المواطنين بالقانون والمؤسسات، التي تعتبر أساس الانتقال إلى دولة القانون، بل وأساس أي انتقال ديمقراطي. وفي ظل التبييض تغدو لقاءات المصالحات شبيهة بحفلات الزار، ولا تزيد عن كونها لقاءات كاذبة بلا حدود".
على المستوى الموضوعي في تحليل كارثة يناير فما يحدث هو "تبييض" للقتلة يعمل على استدامة وتناسل الكارثة. لكن على المستوى الشخصي فإن الكتاب هو أيضا "تبييض للذات" كي تستمر من موقعها النبوي دون اقتصاص من صمتها أو تواطئها! ألم ينعقد مؤتمر منظمة الصحفيين بعد شهر من الكارثة ليدين زملاءهم الذين "استشهدوا" قتلاً؟! هل يكفي حديث الكاتب العابر عن إدانة مؤتمر منظمة الصحفيين لمن قتلوا من زملائهم ووصفهم بالمتآمرين وغيرها من الصفات؟! هل يكفي المرور العابر على الدور الشخصي في سياقه العام لكي يتطهر الكاتب، وهو الذي استمر منذ الكارثة الينايرية وحتى عام 1993 ضمن استحقاقات "الطغمة" كمدير لتحرير صحيفة "14 أكتوبر" الرسمية في عدن، ورئيس لتحرير مجلة "الوطن" (1990-1993) في دولة الوحدة؟!
ولأن "الوضع الرجراج والمائع يشجع معظم المنحدرين من سلالة القتلة وأنجالهم على أن يكونوا من العناوين الصارخة للمشهد الدموي الراهن كـ"ورثة رسالة" أو كمن يتكئ بافتخار على بطولات وأمجاد سابقة"، على تعبير الكاتب، فإن الكتاب والكاتب لم يفكك هذا الوضع الرجراج بالمكاشفة ولو بحدها الأدنى، فنصيحة رفاقه وزملائه بأن الكلام في هذا الوقت فتنة، قد جعلت الكتاب والكاتب أقرب إلى الصمت المباح منه إلى البوح الذي تتخلق الفتنة منه، أي افتتان القتلة، وسحب بساط التبييض من تحت أقدامهم، وجعلهم في العراء دون أقنعة "رسالية".
ما هو عام في التحليل تميز به هذا الكتاب، فـ13 يناير هو نتيجة لمسار من "موروث الانقسام المديد بين الأقوام والجماعات المحلية، القبائل والعشائر، الإمارات والسلطنات والمشيخات الكبيرة والمايكروسكوبية. وقد عمل المستعمر البريطاني على تغذية ذلك الموروث وتمويله وتفعيله انطلاقا من اقتناعه واعتقاده بأن دعم القبائل في تقاتلها البيني على الموارد والنفوذ يصب في خدمة استدامة انحلاله بأقل كلفة وبأكثر واقعية ونجاعة". بعد ذلك كان الانتصار لفوهة البندقية وإزاحة العقل من ممهدات كارثة يناير، لهذا كان الأكثر قوة وبداوة هو المعبر عن المرحلة" في هذا المنعرج انطوى المعنى على تظهير عضلات الأكثر قوة وشراسة وبداوة. وكانت المناطق الأكثر فقراً هي "البؤرة الثورية" الطليعية لحساب انحسار قوة العقل وانكماشه وكسوفه. من "صرخة الجبهة القومية: كل الشعب جبهة قومية، كان الانتقال من استعمار الأرض بريطانياً إلى استعمار الشعب جبهوياً! وتحول القتل إلى عقيدة أيديولوجية"، على حد تعبير الكاتب، "وتدمير وإبادة كل آخر، وإقصاء واغتيال كل مناسبة للحياة في خضم الصراع الضاري والعاري من أجل السلطة بما هي جيب يكتنز المغانم ومعطى نهائي للامتيازات والمصالح. وكانت القبائل المقاتلة هي الأسرع في الاستحواذ عليه من أوسع الأبواب وأشدها فتكاً: القتل".
لقد ساهم الاستعمار البريطاني، من خلال مندوبه السامي (همفري تريفليان) وقائد الجيش النظامي (داي)، في أن تكون كل السلطة بيد الجبهة القومية. فبحسب شهادة الأستاذ علي السلامي، التي أوردها في ورقته المقدمة إلى "الندوة الوطنية التوثيقية للثورة اليمنية"، التي عقدت عام 1991 وطبعت في كتاب صادر عن مركز الدراسات والبحوث اليمني-صنعاء عام 1993م، إذ يؤكد في ورقته أن المندوب السامي وقائد الجيش البريطاني سابق الذكر اجتمعا بكبار الضباط في الجيش الاتحادي بتاريخ 7-11-1967م، أي قبل موعد الجلاء بأسابيع، وأبلغاهم أن حكومة صاحبة الجلالة قررت أن تسلمكم الاستقلال، فاعترض الأخ سالم أحمد العتيقي، وقال: "الثوار أيش مصيرهم؟!". وتكلم قائد الجيش الاتحادي محمد أحمد موقع، وقال: "يا صاحبي هذه مفاجأة". وانقسم الضباط. وعقد اجتماع آخر استثني منه سالم احمد عتيقي واستبدل عبد الله أحمد عتيقي (من أعضاء جبهة التحرير). وفي هذا الاجتماع أبلغ قائد جيش الاتحاد النظامي البريطاني أن على الجيش الاتحادي أن يساند الجبهة القومية، وأن يعمل على إخراج جبهة التحرير من المنصورة والشيخ عثمان، بعد أن كانت قد سيطرت على المنطقة من لحج إلى المنصورة. وتم إقالة الضباط الذين اعترضوا على ذلك، وكان رأيهم أن الاستقلال ينبغي أن يسلم لجبهة التحرير والجبهة القومية معا (علي السلامي: الندوة الوطنية التوثيقية للثورة اليمنية، ص201 ـ 202).
من حكومة الثورة كانت القصدية في اختيار أسماء إسلامية للشوارع والمدارس والمعسكرات: معسكر طارق بن زياد وصلاح الدين وشارع أبو عبيدة بن الجراح، ومعسكر فتح، ومنه جاءت تسمية "سجن الفتح" نسبة للمكان الذي بني فيه، وقد كان داخل المنطقة التي تسمى "فتح" والسجن بني في مكان لتجميع القمامة يسمى "الشولة" بحسب الكاتب.
لقد كان الكتاب كسردية تعبيرية عن حالة العدمية المتلفعة بلغة النبوة والتيه في آن، فالكاتب بحسب تعبيره "مترحل في الفراغ"، تتقاذفه البراري، والبرية تحضر في كتابه كرديف للبداوة، وشُرَّاب الدم، لا تحتوية جهة ولا جبهة، ولا يقيم على الأرض "مترحل شريد مطارد، نازح بلا موعد آخر، ومثخن بالحروب دون قسط من راحة أو حتى هدنة تكفي لكتابة مشروعي «شهادتي". نعم، ما زالت الكتابة / الشهادة مؤجلة، خوفَ فتنة الذات والجماعة، فالوقت لم يحن بعد. ويبدو أنه لا يزور هذه البلاد أبدا، وكذلك هو حال الوضع، فهو "لا يستقر ويبدو أنه لن يستقر في قادم الأيام والأعوام بإصرار من يستكثر عليّ الانتفاع بهدنة موجزة تكبح اندفاعي في هرولة الهرب الأبدي". إنها الكتابة / الهروب، الرجراجة دون إبانة! ومن هنا يسقط زعم الكاتب أنه ينطلق في كتابته من أرضية أنه "لا رئيس عليه إلاَّ رأسه"، فالأوصياء الخفيون كانوا من الكثرة بحيث ألجموا كتابته الصارخة التي ينبغي أن تكون، لكن وإن تحولت إلى أنين فهو أنين سردي في ظني مهم، بل ومن علامات السرد اليمني عن الحرب، كتب بلغة مقتدر تحليلاً وتخليقاً، وسكوتاً.
يعزز الكاتب في "أطيافه" و"شهادته"، التي ترقى لأن تكون عملاً روائياً مميزاً، من تصوير ذاته الساردة على أنه يريد أن يتعافى مما سميته سابقا "الصوت والصورة"، فإثم مشاهداته لزملائه وهم يساقون إلى براري الإعدامات، ومقصلة محكمة "الطغمة"، صورة الحنكي من فتحة ضيقة في طربال السيارة التي حملوه معتقلاً عليها، وصوت فاروق علي أحمد بحنوه وعتبه الموغل في الجرح... لهذا يستقصي الكاتب أعمالاً أدبية ومقالات لمعتقلين كي يتحرر من هاوية وعقدة "الناجي الوحيد"، فيكثف المعنى مستشهداً برواية الفرنسي جان نويل بانكرازي: "الجبل"، والتي تحكي ذكريات الحرب وجراحها في حرب التحرير بالجزائر. حينها كان طفلاً ذهب أصدقاؤه، وصعدوا إلى خلفية الشاحنة، مستجيبين لعرض سائقها أن يصطحبهم إلى الجبل، ووحده بانكرازي تخلف عنهم، ليكون هو الناجي الوحيد، فقد عثروا على الأطفال الستة مقتولين.
ويعزز الكاتب دلالة الضحية من خلال الاستشهاد بكتابات ياسين الحاج صالح بمقاومة الاستسلام للإصابة بـ"عقد الناجي" وأثرها في تعطيل الزمن وشروط الصراع وضرورة إصلاح الأدوات. لكن منصور هايل في سرديته الينايرية يسقط في التيه والعدمية والخيال، في أدواته وزمنه ورؤيته.
ربما كان الكاتب في استشهاده برواية "الحارس في حقل الشوفان" متمثلاً لنموذج المراهق المتمرد على مجتمعه، يزدري هذا المجتمع ويرى أفراده جميعا غارقين في نوع من الزيف والغباء"! هناك علاقة في الموقف بين منصور وبطل رواية "الحارس في حقل الشوفان"، تتمثل في النزوع لتأثيم المجتمع، كحيلة للتحرر والتطهر من الإثم.
يخاطب الكاتب ذاته بلغة الوصايا، مبيناً لها ما يجدر بها، قائلاً بصوت التمني: "يجدر بك أن تجتر خيباتك ومراراتك وخساراتك وحسراتك، ولا تتسرع في الهرولة إلى أصدقاء الحنين والكآبة واللاجدوى و"رفاق" الأيام الخوالي وأحلام الخلاص والفاقة، كي تتمكن من الكتابة بضوء القلب، وتقترح للمدينة سماء أخرى تتسع للحياة". وبما أن المدينة والمثقف مرتبطان عضوياً فإن المثقف بأمس الحاجة إلى ضوء القلب، وإلى سماء بأفق جامع لا يضيق بوطنية يمنية جامعة، ولا يطمر الجرح الشخصي بالحديث عن ذاكرة جمعية هي حاصل جمع كل التفاصيل وضوحاً وعتمة. وهنا تأتي تداعيات الكاتب مع نفسه، ومنها حديثه عن "الزهايمر" وعن "الوعي الشقي"، فالشقاوة هنا تلطيف إن لم تكن مواراة لموقف إبان كارثة يناير وما بعدها، وإرجاء متعمد بذريعة النسيان اللاإرادي.
تختلط "الصور والعناوين والمواعيد" في ذهن الكاتب وذاكرته "بتطرف تجاوز كل الحدود المتعارف عليها للتشوش والارتباك، وتهاوت التخوم الفاصلة بين مواعيدي (التاريخية) ولم أعد أتذكر ما إذا كنت دخلت الحزب قبل الحرب أم الحرب قبل الحزب، فيما ترجيحات الشواهد والإشارات تفيد بأني دخلتهما في موعد واحد، فهما واحد في هذه البلاد، وليس ثمة ما يمنع حذف النقطة الرابضة على (الراء) وكافة النقاط الساهرة على حبس (العربية) وأنفاس العباد والبلاد".

.jpg)









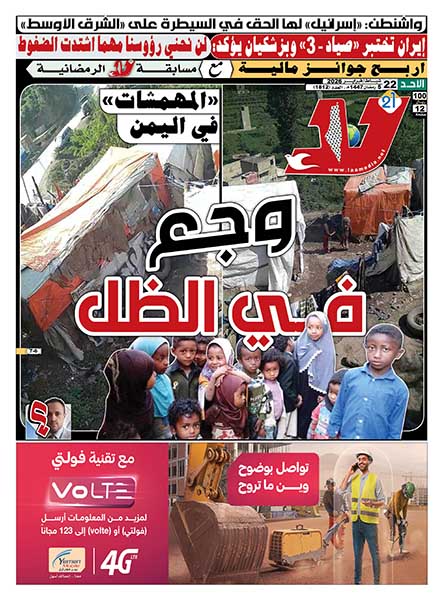





المصدر محمد ناجي أحمد
زيارة جميع مقالات: محمد ناجي أحمد